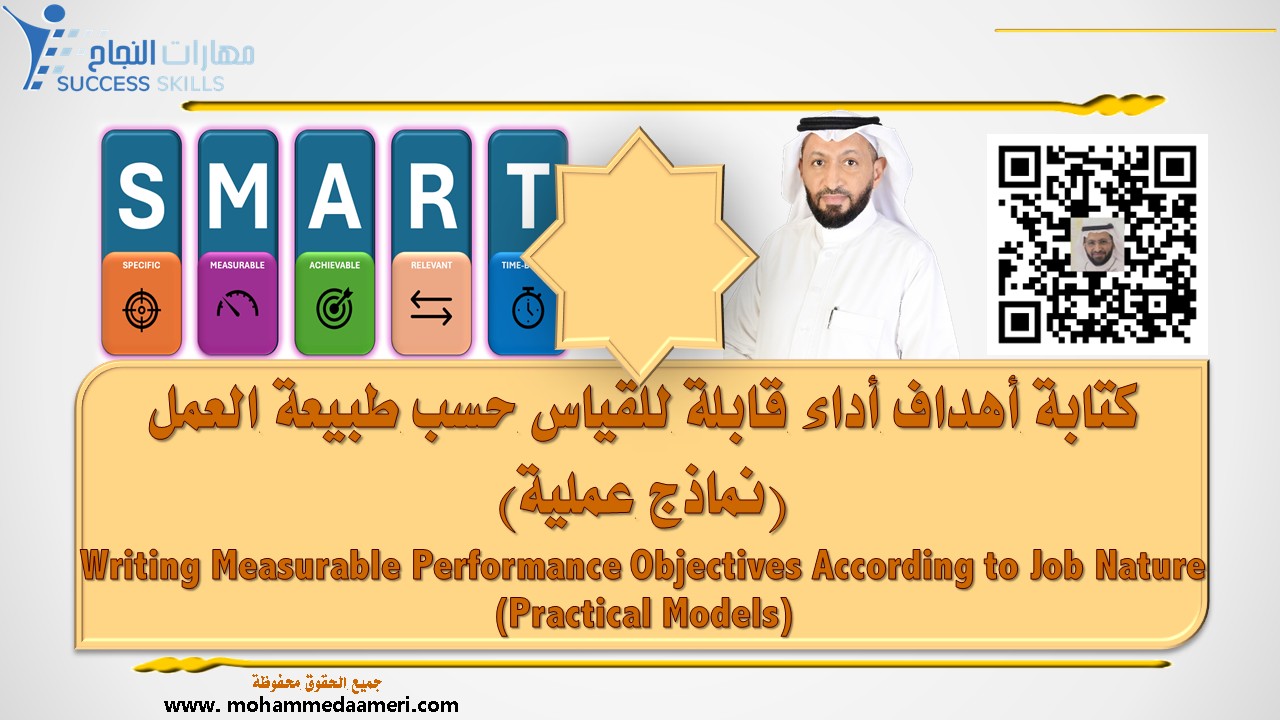حين تصل المؤسسة إلى مرحلةٍ تُدرك فيها أنّ الأداء ليس مجرّد تنفيذٍ للمهام، بل هو انعكاسٌ لوعي الفرد بما يُسهم به في تحقيق غايات المؤسسة، تبدأ الحاجة الحقيقية إلى صياغة أهدافٍ واضحةٍ قابلةٍ للقياس تُعبّر بدقةٍ عن طبيعة كل دورٍ وظيفي. فالهدف الوظيفي ليس جملةً إنشائيةً تُزيّن ميثاق الأداء، بل هو “عقدُ وعيٍ مهنيٍّ” بين الموظف والمؤسسة، يُحدّد ماذا سيُنجز، وكيف سيُنجزه، وبأيّ معايير سيُقاس نجاحه. وفي عالمٍ يتسارع فيه التغيير، ويتّسع فيه نطاق المسؤوليات، لم يعد مقبولًا أن تُترك الأهداف للحدس أو الاجتهاد الشخصي، بل أصبحت صياغتها علمًا له قواعده، وفنًّا له منطقه، وأداةً استراتيجيةً لضمان العدالة والتحفيز والشفافية في تقييم الأداء.
إنّ كتابة الأهداف القابلة للقياس تُشكّل جوهرَ عملية إدارة الأداء الوظيفي، لأنها تُحوّل الجهد الفردي إلى قيمةٍ مؤسسيةٍ ملموسةٍ يمكن متابعتها وتحسينها. فالمؤسسات التي تُتقن هذه المهارة تُدير أعمالها بالنتائج لا بالنوايا، وبالبيانات لا بالانطباعات، وبالمعايير لا بالعلاقات. وحين يُصبح الهدف مكتوبًا بوضوحٍ، يمكن قياسه، وتحليله، ومراجعته، وتطويره، فيتحول الأداء إلى علمٍ يُدار لا إلى شعورٍ يُقدّر. ولهذا فإنّ نجاح أي نظامٍ للأداء يبدأ من جودة الأهداف، لأنّ ما لا يُكتب بدقةٍ لا يُقاس بعدالة، وما لا يُقاس بعدالةٍ لا يُدار بفاعلية.
وفي جوهر هذه العملية، تُطرح الأسئلة الكبرى التي تُشكّل عمق الوعي المؤسسي: ما طبيعة عملي؟ ما القيمة التي أُضيفها؟ كيف أعرف أنّني أنجزت فعلاً؟ وما المؤشرات التي تُثبت ذلك؟ هذه الأسئلة هي التي تُحوّل الموظف من منفّذٍ إلى مفكّرٍ، ومن تابعٍ إلى مساهمٍ، ومن متلقٍّ للتوجيه إلى صانعٍ للنتيجة. فحين يُدرك الفرد أنّ هدفه ليس مجرد “مهمةٍ مطلوبةٍ منه”، بل هو “أثرٌ ينتج عنه”، تتغيّر طريقة تفكيره، فيبدأ بالنظر إلى عمله كحلقةٍ في سلسلة القيمة المؤسسية، لا كمجهودٍ فرديٍّ معزولٍ. وهنا يتحول الأداء إلى وعيٍ ذاتيٍّ، والهدف إلى بوصلةٍ داخليةٍ تُوجّه السلوك اليومي نحو الغاية الكبرى.
إنّ الصعوبة التي تواجه كثيرًا من المؤسسات ليست في غياب الأهداف، بل في غموضها، أو تكرارها، أو ضعف ارتباطها بالواقع العملي. فكثيرٌ من الأهداف تُكتب بلغةٍ عامةٍ لا تُعبّر عن حقيقة الدور الوظيفي، فتفقد معناها وتُصبح حبرًا على ورق. ولذلك فإنّ التحدي ليس في كتابة هدفٍ جميلٍ، بل في كتابة هدفٍ واقعيٍّ محددٍ قابلٍ للقياس يرتبط مباشرةً بطبيعة الوظيفة. فهدف الموظف الإداري يختلف عن هدف الفني، وهدف القائد يختلف عن هدف المنفّذ، وهدف المختص في الجودة يختلف عن هدف المختص في التدريب. إنّ لكل وظيفةٍ منطقها وأولوياتها ومؤشراتها، وكل هدفٍ يجب أن يُصاغ بما يعكس جوهر هذه الخصوصية.
وحين نُحلّل التجارب الخليجية الحديثة في إدارة الأداء — وعلى رأسها النظام الإماراتي والدليل الإرشادي السعودي — نجد أنّها ركّزت على ضرورة أن تُعبّر الأهداف عن “المسؤوليات الجوهرية” في الدور الوظيفي، وأن تتنوّع بين أهدافٍ تشغيليةٍ تُقيس الإنجاز اليومي، وأهدافٍ تطويريةٍ تُقيس التحسّن والنمو، وأهدافٍ سلوكيةٍ تُقيس طريقة الأداء. هذا التنوّع يُعطي التقييم عمقًا وعدالةً، ويضمن أن يُقاس الموظف على ما يُمثّل جوهر عمله لا على مهامٍ عرضيةٍ. فالقيمة ليست في عدد الأهداف، بل في دقتها وارتباطها المباشر بالنتائج ذات الأثر المؤسسي.
ولأنّ الهدف هو لبّ نظام الأداء، فقد باتت المؤسسات المتقدمة تُخصّص ورشًا سنويةً لتدريب موظفيها ومديريها على كتابة الأهداف وفق منهجياتٍ علميةٍ موحّدةٍ. فكتابة الهدف مهارةٌ تحتاج إلى تدريبٍ، لأنها تجمع بين التحليل المنطقي والفهم التنظيمي واللغة الدقيقة. فهي ليست مجرد تمرينٍ لغويٍّ، بل عمليةُ تفكيرٍ إداريٍّ متكاملةٍ تبدأ من فهم الرؤية وتنتهي بتحديد المؤشر. ولهذا فإنّ الموظف الذي يتقن كتابة هدفٍ واضحٍ يُثبت أنه يُدير عمله بعقليةٍ قياديةٍ. أما من يكتب أهدافًا غامضةً أو عامةً أو غير قابلةٍ للقياس، فإنه يُدير وقته بلا بوصلةٍ، ويُجهد نفسه دون أثرٍ يُقاس.
ومن هنا تأتي أهمية هذا المقال الذي يُقدّم منهجيةً عمليةً لكتابة الأهداف القابلة للقياس وفق طبيعة العمل، مستندًا إلى النماذج الخليجية الرسمية والممارسات العالمية. فهو لا يُقدّم وصفًا نظريًا، بل يُقدّم خرائط تطبيقيةً توضّح كيف تتحوّل المهام اليومية إلى أهدافٍ مؤسسيةٍ، وكيف يُترجم الجهد الفردي إلى قيمةٍ قابلةٍ للقياس، وكيف تُبنى العدالة في التقييم على أساس الدقة في الصياغة. فكل هدفٍ يُكتب بطريقةٍ صحيحةٍ هو خطوةٌ نحو العدالة التنظيمية، وكل هدفٍ يُكتب بوعيٍ هو لبنةٌ في بناء ثقافة الأداء المستدام.
إنّ جوهر عملية كتابة الأهداف هو بناءُ “لغةٍ تنظيميةٍ مشتركةٍ” داخل المؤسسة. فحين يتحدث الجميع بلغة الأهداف نفسها، ويستخدمون المعايير ذاتها، تُصبح المؤسسة متناغمةً في اتجاهها وسلوكها. هذه اللغة هي التي تخلق “ثقافة القياس” التي تقوم عليها التميز المؤسسي (EFQM) والمواصفة الدولية لإدارة رأس المال البشري (ISO 30414). وحين تتحدث الأرقام بلغةٍ واحدةٍ، تُصبح القرارات أكثر عدالةً، ويُصبح الأداء أكثر استدامةً.
وفي النهاية، فإنّ الهدف القابل للقياس ليس مجرد مؤشرٍ إداريٍّ، بل هو وعدٌ مهنيٌّ بين الإنسان والمؤسسة، يلتزم فيه الطرفان بالوضوح والصدق والمساءلة. فالمؤسسة تعدُ بأن تُقيّم بعدل، والموظف يعدُ بأن يُنجز بمعيارٍ واضحٍ. وحين يتحقق هذا الوعد، تتوازن العلاقة بين العمل والنتيجة، وبين الأداء والتقدير، وبين الواجب والتحفيز. وهكذا تتحول الأهداف من أدواتٍ للرقابة إلى أدواتٍ للنمو، ومن معيارٍ للمحاسبة إلى وسيلةٍ للتمكين.
📚 فهرس المقال
1️⃣ 🧠 جوهر الهدف الوظيفي: من الفكرة إلى القيمة القابلة للقياس
تحليل فلسفة الهدف ودوره في تحويل الجهد الفردي إلى أثرٍ مؤسسيٍّ ملموسٍ.
2️⃣ ⚙️ خصائص الهدف الجيد: معايير الصياغة الاحترافية في ضوء نموذج SMART وCLEAR
توضيح الأسس العلمية لكتابة أهدافٍ دقيقةٍ تُعبّر عن الواقع وتُحفّز الأداء.
3️⃣ 🧩 أنواع الأهداف الوظيفية: التشغيلية، التطويرية، والسلوكية
تصنيف الأهداف وفق طبيعة العمل ومستوى الوظيفة وربطها بمستويات الأداء المؤسسي.
4️⃣ 📊 تحويل المهام اليومية إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس
شرح الخطوات العملية لتحويل النشاط إلى هدفٍ يُقاس بالمؤشر والنتيجة.
5️⃣ 🧮 نماذج الصياغة المتدرجة حسب المستويات الوظيفية
تطبيقات عملية توضّح الفرق بين الأهداف التشغيلية للموظفين والأهداف القيادية للمشرفين والمديرين.
6️⃣ 🧭 أخطاء شائعة في كتابة الأهداف وكيفية تصحيحها
تحليل لأبرز الأخطاء الواقعية في ممارسات كتابة الأهداف مع حلولٍ تصحيحيةٍ منهجيةٍ.
7️⃣ 💡 الأهداف في الأنظمة الخليجية الرسمية: من الدليل الإرشادي السعودي إلى النظام الإماراتي
قراءة تحليلية مقارنة لأبرز التوجيهات والمعايير الرسمية في صياغة الأهداف.
8️⃣ 🌍 من الهدف إلى المعيار: بناء بيئة قياسٍ واعيةٍ تدعم العدالة والتطوير المستمر
ربط الأهداف بالحوكمة المؤسسية، والشفافية، والتحسين المستمر كجزءٍ من ثقافة الأداء.
🧠 جوهر الهدف الوظيفي: من الفكرة إلى القيمة القابلة للقياس
حين نتحدث عن الهدف الوظيفي، فإننا لا نتحدث عن صياغة لغوية أو جملةٍ رسميةٍ تُدرج في ميثاق الأداء السنوي، بل عن أداةٍ فكريةٍ استراتيجيةٍ تُحوّل النية إلى التزام، والفكرة إلى خطة، والجهد إلى نتيجةٍ يمكن قياسها. الهدف الوظيفي هو “لغةُ الوعي الإداري” التي تتحدث بها المؤسسة مع موظفيها، والمرآة التي يرى فيها الموظف أثره الحقيقي في منظومة العمل. فالهدف ليس وعدًا غامضًا بالإنجاز، بل اتفاقٌ معرفيٌّ على المعنى والاتجاه والأثر. إنه المعادلة التي تجمع بين لماذا نعمل؟ وكيف نعرف أننا نجحنا؟.
في جذور الإدارة الحديثة، يُعتبر الهدف هو نقطة البداية لكل عمليةٍ تنظيميةٍ واعيةٍ. فبدونه لا معنى للتخطيط، ولا اتجاه للتنفيذ، ولا معيار للتقويم. ومن هنا يُقال إنّ “الهدف هو المِعيار الذي يُعطي للزمن قيمته”. فالعمل الذي لا يُوجَّه لهدفٍ محددٍ هو جهدٌ مبعثرٌ، مهما كان نبيلاً في نواياه. لذلك تُعدّ كتابة الهدف الوظيفي أول ممارسةٍ عقلانيةٍ في إدارة الأداء، لأنها تُحوّل الحماس إلى نظام، والطموح إلى مسار، والنية إلى نتيجةٍ يمكن مراجعتها وتطويرها.
الهدف الوظيفي في جوهره ليس وصفًا لما نريد أن نفعله، بل لما نريد أن نُحدثه من تغييرٍ ملموسٍ. فهو لا يصف النشاط بل النتيجة، ولا يُقاس بالجهد بل بالأثر. فالفرق بين الموظف الذي يقول “سأعدّ تقارير أسبوعية” والآخر الذي يقول “سأُقدّم تقارير تحليلية تُسهم في تحسين دقة القرارات بنسبة 20٪” هو الفرق بين من يُمارس العمل ومن يُدير القيمة. الأول يُنتج وثيقة، والثاني يُنتج أثرًا. ومن هنا يُصبح الهدف الجيد ليس ما يُعبّر عن ماذا سنفعل فحسب، بل ما يُجيب أيضًا عن ما القيمة التي سنُضيفها من خلال ما نفعل.
إنّ هذا التحول من النشاط إلى الأثر هو ما يُميّز المؤسسات الناضجة. ففي الممارسات الإدارية التقليدية، كان الموظف يُقيَّم على أساس عدد التقارير أو سرعة الإنجاز أو الحضور والانصراف. أما في الإدارة الحديثة، فإنّ القياس انتقل من كم أنجزت؟ إلى كيف أثّر إنجازك في النتيجة النهائية؟. فالموظف الذي يُنجز كثيرًا دون أثرٍ ملموسٍ هو كمن يحرّك الماء دون أن يُغيّر اتجاه النهر. ولذلك، فإنّ الهدف الوظيفي حين يُصاغ بوعيٍ يُصبح بوصلةً استراتيجيةً تُوجّه الطاقة المؤسسية نحو الاتجاه الصحيح.
وفي هذا الإطار، يُمكننا أن نُفرّق بين ثلاثة مستوياتٍ من الأهداف تُعبّر عن ثلاث درجاتٍ من الوعي الإداري:
1️⃣ الهدف الإجرائي: وهو الذي يُركّز على ما سيتم فعله. مثال: “إعداد تقارير أسبوعية”.
2️⃣ الهدف الوظيفي الواعي: وهو الذي يربط ما سيتم فعله بالنتيجة المرجوّة. مثال: “إعداد تقارير أسبوعية تُسهم في تحسين المتابعة التشغيلية”.
3️⃣ الهدف القيمي المؤسسي: وهو الذي يربط النتيجة المرجوّة بالأثر المؤسسي النهائي. مثال: “إعداد تقارير أسبوعية تُسهم في تحسين المتابعة التشغيلية بما يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة بنسبة 20٪ وتحسين رضا المستفيدين”.
وهذه المستويات الثلاثة تُشكّل سلم النضج في كتابة الأهداف. فكلما ارتقى الموظف في وعيه، ارتقى هدفه من “نشاطٍ ميكانيكيٍّ” إلى “قيمةٍ استراتيجيةٍ”. إنّ جوهر الهدف الوظيفي هو هذا الارتقاء من الحركة إلى التأثير، ومن الجهد إلى الجدوى.
ولأنّ الهدف هو جسر التواصل بين الفرد والمؤسسة، فإنّ وضوحه يُعبّر عن جودة العلاقة بينهما. فالمؤسسة التي تُحدّد أهدافًا غامضةً أو متناقضةً تُرسل لموظفيها رسالةَ ضبابٍ في الاتجاه. والموظف الذي يكتب هدفًا فضفاضًا يُفقد نفسه القدرة على التقييم العادل لاحقًا. فالهدف هو وعدٌ بالإنجاز، وكل وعدٍ غامضٍ هو بابٌ مفتوحٌ للظلم أو التبرير. ومن هنا تنبع أهمية الدقة اللغوية والمنهجية في صياغة الهدف، لأنها ليست مسألة شكلٍ إداري، بل مسألة عدالةٍ تنظيميةٍ وأخلاقٍ مهنيةٍ في المقام الأول.
إنّ الهدف الوظيفي يُعيد تشكيل الهوية المهنية للموظف، لأنه يُعرّف دوره في اللغة التي تفهمها المؤسسة: لغة القيمة. فحين يقول أحدهم: “هدفي هو إنجاز أعمالي اليومية”، فإنه يُعرّف نفسه كمنفّذ. أما حين يقول: “هدفي هو ضمان دقة العمليات اليومية بما يضمن جودة المخرجات”، فإنه يُعرّف نفسه كصانع جودةٍ ومسؤولٍ عن النتيجة. وهكذا يُصبح الهدف انعكاسًا لمستوى التفكير الذي يحكم العلاقة بين الإنسان والعمل. ولهذا فإنّ المؤسسات التي تُدرّب موظفيها على كتابة الأهداف تُدرّبهم في الواقع على التفكير المنهجي والتحليل السببي واتخاذ القرار.
ومن الناحية النفسية، فإنّ الهدف الوظيفي يُؤسّس لمفهوم “المعنى في العمل”. فالإنسان حين يعرف لماذا يعمل، وكيف يُسهم في الصورة الكبرى، يشعر بالانتماء والتحفيز الذاتي. والموظف الذي يرى أثر عمله لا يحتاج إلى مراقبةٍ، لأنه يُراقب ذاته من خلال المعنى. ولهذا فإنّ الأهداف القابلة للقياس لا تُبنى فقط لضبط الأداء، بل لبناء الحافز الداخلي الذي يجعل الالتزام سلوكًا نابعًا من القناعة لا من التعليمات. فالقياس هنا ليس غايةً رقابيةً، بل وسيلةٌ تربويةٌ لإعادة تشكيل وعي العاملين بعلاقة الجهد بالنتيجة، والنتيجة بالأثر، والأثر بالقيمة.
وفي الفكر الإداري الخليجي الحديث، خاصة في النماذج الإماراتية والسعودية، أصبح الهدف الوظيفي يُعدّ أحد الأدلة المركزية على نضج المؤسسة في إدارة رأس مالها البشري. إذ يُنظر إلى جودة الأهداف على أنها مؤشرٌ مباشرٌ على جودة التفكير المؤسسي. فكل هدفٍ يُكتب هو دليلٌ على وعيٍ إداريٍ تمارسه المؤسسة مع موظفيها. ولهذا تُعتبر عملية مراجعة الأهداف في بدايات دورة الأداء من أهم لحظات “الضبط المعرفي” في إدارة الأداء، لأنها تكشف جودة الفكر الإداري أكثر مما تكشف جودة الكتابة.
ومن الناحية الأخلاقية، يُعبّر الهدف الوظيفي عن صدق المؤسسة مع موظفيها. فحين تُوضّح المؤسسة ما تتوقعه من كل موظفٍ بوضوحٍ وموضوعيةٍ، فإنها تُمارس العدالة التنظيمية التي تُزيل الالتباس وتُعزز الثقة. والعكس صحيح، فالأهداف الغامضة تُولّد الخوف والشك، وتفتح المجال للتقييم غير العادل، وتُضعف الانتماء. لذلك، فإنّ كتابة الهدف هي في حقيقتها فعلُ شفافيةٍ ومسؤوليةٍ مؤسسيةٍ أكثر من كونها إجراءً إداريًا.
وهكذا، فإنّ جوهر الهدف الوظيفي يتجاوز فكرة “ما سأفعله” إلى “لماذا أفعله، ولمن، وما أثره؟”. وكلما استطاعت المؤسسة أن تُربّي هذا النوع من التفكير في موظفيها، اقتربت من بناء بيئة عملٍ تحكمها المعايير لا المزاج، والبيانات لا الانطباعات، والمعنى لا الشكل. فالهدف هو البذرة الأولى في شجرة الأداء، ومن طبيعته تتحدد جودة الثمار. فإذا زُرع الهدف بوعيٍ، نضجت الثمار عدلًا وتميّزًا ونموًّا مستمرًّا.
⚙️ خصائص الهدف الجيد: معايير الصياغة الاحترافية في ضوء نموذجَي SMART وCLEAR
حين يبدأ الموظف بكتابة هدفه، يكون في الحقيقة أمام امتحانٍ مزدوجٍ: امتحان الفكر وامتحان اللغة. فالكلمة هنا ليست أداةَ وصفٍ، بل أداةُ إدارةٍ وتوجيه. إنّ الهدف الذي يُكتب بعنايةٍ هو أقرب إلى "عقدٍ فكريٍّ" بين الفرد والمؤسسة، يربط المعنى بالفعل، والإرادة بالقياس، والرؤية بالتحقق. ولذلك، فإنّ خصائص الهدف الجيد ليست ترفًا تنظيميًا، بل ضرورةٌ لضمان العدالة، والشفافية، والتحفيز، والفاعلية.
لقد اجتهد الفكر الإداري الحديث في وضع أطرٍ علميةٍ تضمن صياغة الأهداف بطريقةٍ منضبطةٍ، فظهرت نماذج متعددة، أبرزها نموذج SMART الذي يُعدّ الأوسع استخدامًا في المؤسسات الحكومية والخاصة، ثم نموذج CLEAR الذي أضاف بُعدًا إنسانيًا وتفاعليًا على كتابة الهدف. والوعي بهذين النموذجين ليس غايةً نظريةً، بل هو حجر الزاوية في بناء ثقافةٍ مؤسسيةٍ واعيةٍ بالأداء، لأنّ المؤسسة التي تُحسن كتابة الهدف تُحسن بناء الإنسان الذي يُنفّذه.
🧩 أولًا: نموذج SMART — من الغموض إلى الدقة
يُعدّ نموذج SMART أحد أهم الأدوات الكلاسيكية في علم إدارة الأداء، وقد وُضع لتوجيه عملية صياغة الأهداف بحيث تُصبح واضحة، قابلة للقياس، واقعية، مرتبطة بالنتائج، ومحددة زمنيًا. هذه الحروف الخمس تمثّل خمس خصائص رئيسية تُحوّل الهدف من عبارةٍ عامةٍ إلى التزامٍ عمليٍّ محدّدٍ:
1️⃣ Specific – محدد:
أن يكون الهدف واضحًا لا يحتمل التأويل. فالوضوح يُزيل الغموض ويُوجّه الجهد بدقة. إنّ قولنا "تحسين الأداء الإداري" هدفٌ عامٌّ لا يمكن الحكم عليه، بينما "تحسين دقة التقارير الإدارية من خلال مراجعة أسبوعية منتظمة بنسبة 100%" هو هدفٌ محددٌ يعرف الموظف ما الذي سيقوم به بالضبط. فكلما زادت خصوصية الهدف، زاد احتمال تحقيقه.
2️⃣ Measurable – قابل للقياس:
القياس هو قلب نظام الأداء. فلا قيمة لهدفٍ لا يُقاس، لأنّ ما لا يُقاس لا يُدار. والمقصود بالقياس هنا ليس الأرقام فقط، بل أيضًا المؤشرات السلوكية والنوعية التي تُظهر الأثر. فعندما نُحدد هدفًا مثل "رفع رضا العملاء بنسبة 10%"، فنحن نُقدّم معيارًا موضوعيًا يمكن متابعته وتحليله ومراجعته. أما الهدف غير القابل للقياس فهو كالبوصلة بلا إبرة، لا تُوجّه أحدًا.
3️⃣ Achievable – قابل للتحقيق:
إنّ الهدف الجيد هو الذي يُحفّز دون أن يُحبط. فالمبالغة في الطموح تُولّد الفشل، والتواضع المفرط يُولّد الركود. القائد الذكي هو من يعرف كيف يُوازن بين التحدي والإمكان، فيضع للموظف هدفًا يُوسّع قدراته دون أن يُرهقه. فليس المطلوب أن يُكسر السقف، بل أن يُرفع تدريجيًا بطريقةٍ واعيةٍ تُبقي الموظف في دائرة الإنجاز لا العجز.
4️⃣ Relevant – ذو صلة:
يجب أن يكون الهدف مرتبطًا بمهام الوظيفة وبالاتجاه الاستراتيجي للمؤسسة. فالهدف المنفصل عن الواقع أو غير المنسجم مع الأولويات يُصبح عبئًا لا قيمة له. في نظام الأداء الناضج، لا يُقبل أي هدفٍ لا يُظهر بوضوحٍ كيف يُسهم في تحقيق نتيجةٍ مؤسسيةٍ أوسع. وهذا هو معنى "التكامل المؤسسي"، الذي يجعل كل هدفٍ فرديٍّ جزءًا من منظومةٍ كبرى.
5️⃣ Time-bound – محدد بالزمن:
الزمن هو إطار الإنجاز، ومن دونه يفقد الهدف معناه. فالمهام اللانهائية تُولّد التسويف، بينما المهام المحددة بزمنٍ تُولّد الالتزام. وعندما يُحدد الموظف أن هدفه سيُنجز "خلال الربع الأول من العام"، فإنه يُحوّل الرغبة إلى التزامٍ فعليٍّ يمكن متابعته. فالوقت ليس مجرد رقمٍ، بل هو أداةُ ضبطٍ نفسيٍّ ومؤسسيٍّ تحوّل العمل إلى إنجازٍ واقعيٍّ.
إنّ نموذج SMART — رغم بساطته — يُعبّر عن المنهج العلمي في التفكير الإداري: الوضوح، والتحليل، والقياس، والاتساق، والانضباط. لكنه لا يكفي وحده، لأنه يُركّز على الجانب العقلي من الهدف، ويُهمل أحيانًا الجانب العاطفي والإنساني الذي يُحفّز السلوك. وهنا جاء نموذج CLEAR ليُعيد التوازن بين المنطق والعاطفة في صياغة الأهداف.
💡 ثانيًا: نموذج CLEAR — من الهدف المجرّد إلى الهدف المُلهِم
ظهر نموذج CLEAR استجابةً لحاجة المؤسسات الحديثة إلى أهدافٍ تُحفّز التفاعل الإنساني، وتدعم التواصل، وتُراعي التغير المستمر في بيئة العمل. فالأداء ليس عمليةً ميكانيكية، بل هو نتاجُ تفاعلٍ بين الإنسان والنظام. وإذا كانت الأهداف الذكية (SMART) تُعنى بالمنهج، فإنّ الأهداف الواضحة (CLEAR) تُعنى بالروح. ويتكون هذا النموذج من خمسة عناصر تُعيد بناء الهدف في بعده الإنساني والمؤسسي معًا:
1️⃣ Collaborative – تشاركي:
أي أن يُصاغ الهدف من خلال الحوار، لا بالفرض. فالموظف الذي يُشارك في صياغة هدفه يشعر بالانتماء إليه، ويُصبح أكثر التزامًا بتحقيقه. المشاركة هنا لا تعني فقد السيطرة، بل تعني نقل المسؤولية من الإلزام إلى الالتزام. فالهدف المشترك يولّد الثقة، والثقة تُولّد الأداء.
2️⃣ Limited – محدود النطاق:
الهدف الجيد لا يُحاول أن يُغيّر كل شيءٍ دفعةً واحدةً. فهو محددٌ في نطاقه، مركزٌ في أثره، قابلٌ للإنجاز ضمن الموارد المتاحة. التشتت في الأهداف يُضعف الجهد ويُفقد المؤسسة التركيز. أما التركيز فيهدف إلى “الأقل الذي يُحدث الأثر الأكبر”، وهو من سمات المؤسسات الرشيقة Agile التي تُركّز على الأولويات الاستراتيجية بدلاً من التوسع غير المنتج.
3️⃣ Emotional – مُلهِم ومُحفّز:
الأهداف الفعّالة تُحرّك المشاعر بقدر ما تُحرّك العقول. فالموظف لا يُنجز لأنه يُحاسب، بل لأنه يؤمن. حين يرتبط الهدف بقيمةٍ إنسانيةٍ كتحسين خدمة المستفيدين، أو دعم زملاء العمل، أو تطوير الذات، فإنّه يُولّد دافعًا ذاتيًا يتجاوز حدود المكافأة. فالمؤسسة الذكية تُصيغ أهدافها بطريقةٍ تُلامس الإحساس بالمعنى قبل الإحساس بالواجب.
4️⃣ Appreciable – قابل للتجزئة والتحقيق المرحلي:
الهدف الكبير يُقسّم إلى مراحل صغيرةٍ تُنجز بالتتابع. فالعقل البشري يُحفّز بالإنجاز الجزئي الذي يمنحه شعورًا بالتقدم. وهذا ما يُعرف بـ “تغذية التقدّم (Progress Feedback)”. فبدلًا من هدفٍ سنويٍّ ضخمٍ يُربك الموظف، تُحدّد أهدافٌ مرحليةٌ قصيرةٌ تمنحه شعورًا بالإنجاز المستمر، فتزداد طاقته والتزامه.
5️⃣ Refinable – قابل للمراجعة والتحسين:
العالم يتغيّر، والأهداف الجيدة يجب أن تتكيف. فالهدف ليس نصًا مقدسًا، بل اتفاقٌ قابلٌ للتحديث إذا تغيّر السياق أو ظهرت معطياتٌ جديدة. فالمؤسسة الناضجة تُعلّم موظفيها أن “المرونة ليست ضعفًا بل ذكاء”، وأنّ تعديل الهدف في منتصف الطريق أحيانًا هو الطريق الأقصر لتحقيق النجاح الحقيقي.
إنّ الجمع بين نموذجَي SMART وCLEAR يُنتج ما يمكن تسميته بـ “الهدف المتوازن”، الذي يجمع بين الصرامة العقلية والمرونة الإنسانية. فهو محددٌ وقابلٌ للقياس، لكنه أيضًا مُلهِمٌ وتشاركيٌّ وقابلٌ للتكيّف. وفي هذا التوازن يكمن سرّ الأهداف التي تنجح في الواقع لا على الورق.
🧭 ثالثًا: البعد الفلسفي في معايير الهدف الجيد
وراء كل نموذجٍ من هذه النماذج، تكمن فلسفةٌ في فهم الإنسان والعمل والمؤسسة. فالأهداف ليست مجرد أدواتٍ تقنيةٍ، بل هي ترجمةٌ لموقف المؤسسة من موظفيها: هل تراهم أدواتٍ تنفيذٍ أم شركاءَ وعيٍ؟ فالمؤسسة التي تُطبّق SMART دون CLEAR تُدير الناس كما تُدار الآلات — بالدقة والانضباط فقط. أما التي تدمج بينهما فتُدير الناس كما تُدار العقول — بالفهم والتحفيز والمعنى.
إنّ الهدف الجيد هو الذي يُخاطب “العقل المنطقي” بالوضوح، و“القلب العاطفي” بالإلهام، و“الضمير المهني” بالمسؤولية. ولهذا، فإنّ صياغة الأهداف ليست مهمة الموارد البشرية فقط، بل هي تمرينٌ قياديٌّ في الفهم الإنساني. فالقائد حين يُساعد موظفه على كتابة هدفٍ جيدٍ، فإنه في الواقع يُعلّمه كيف يُفكّر استراتيجيًا، وكيف يُترجم الفكرة إلى فعلٍ، وكيف يُحوّل الرغبة إلى أثرٍ.
وفي التجارب الخليجية الحديثة، بدأنا نرى هذا التوازن جليًا في الأنظمة الجديدة لإدارة الأداء. ففي الدليل الإرشادي للائحة الأداء الوظيفي بالمملكة العربية السعودية مثلًا، نجد تركيزًا على وضوح الأهداف وتحديد مؤشرات القياس بدقةٍ، مع التشديد على ضرورة مناقشتها وتحديثها دوريًا. وفي نظام إدارة الأداء الإماراتي (EPMS) نجد إضافةً محوريةً تتمثل في “الأهداف السلوكية” التي تُقاس من خلال الجدارات والالتزام بالقيم المؤسسية، ما يعكس إدراكًا بأنّ الأداء ليس رقمًا فقط، بل سلوكٌ يُعبّر عن الثقافة المؤسسية.
🌿 رابعًا: من الخصائص إلى الثقافة
حين تُصبح هذه المعايير جزءًا من التفكير اليومي في المؤسسة، تتحول كتابة الأهداف من عمليةٍ إداريةٍ إلى ممارسةٍ ثقافيةٍ. فكل موظفٍ يبدأ عمله وهو يعرف ماذا سيُنجز، ولماذا، وكيف سيُقاس، وبأيّ أثرٍ سيُسهم. عندها تُصبح الأهداف لغةً مؤسسيةً مشتركةً، تُنظّم الحوار بين القيادة والموظفين، وتُحوّل المؤسسة إلى نظامٍ منسجمٍ يفكر بالنتائج ويعمل بالقيم.
إنّ خصائص الهدف الجيد ليست مجرد قواعدٍ للكتابة، بل هي معاييرُ للوعي الإداري. فالموظف الذي يُتقنها يُصبح أكثر انضباطًا، وأكثر تحفيزًا، وأكثر قدرةً على التفكير التحليلي. والمؤسسة التي تُطبّقها تُصبح أكثر عدالةً وفعاليةً واستدامةً. وهكذا يُصبح الهدف أداةَ توازنٍ بين العلم والإنسان، بين العقل والتنظيم، بين القياس والمعنى — وهي الغاية الكبرى من إدارة الأداء الوظيفي حين تُمارس بوعيٍ واستنارةٍ.
🧩 أنواع الأهداف الوظيفية: التشغيلية، التطويرية، والسلوكية
حين نتأمل منظومة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحديثة، نجد أن الأهداف ليست كتلةً واحدةً تُصاغ بالطريقة ذاتها أو تُقاس بالمقياس نفسه، بل هي شبكةٌ من المستويات المتكاملة التي تعكس أبعاد العمل الثلاثة: “ما نفعله”، “كيف نتحسن”، و“من نكون ونحن نعمل”. هذه المستويات الثلاثة تُشكّل ما يُعرف في أدبيات إدارة الأداء بـ أنواع الأهداف الوظيفية، وهي: التشغيلية، والتطويرية، والسلوكية. وكل نوعٍ منها يُعبّر عن وجهٍ من أوجه النضج المؤسسي، ويُساهم في بناء الصورة الكاملة للأداء الإنساني داخل بيئة العمل. فالأداء لا يُختزل في النتائج الرقمية وحدها، ولا في النمو المهني فقط، ولا في السلوكيات الفردية بمعزلٍ عن غيرها، بل في التوازن الديناميكي بين هذه الأبعاد الثلاثة.
🌿 أولًا: الأهداف التشغيلية – من الإنجاز إلى القيمة
الأهداف التشغيلية هي الأساس العملي الذي تقوم عليه الوظيفة اليومية، وهي التي تُترجم المهام إلى نتائجٍ ملموسةٍ قابلةٍ للقياس. إنها الأهداف التي تُعبّر عن “ماذا يفعل الموظف فعليًا” في إطار دوره المحدد. في هذه المرحلة، يتحول الجهد إلى رقمٍ، والزمن إلى خطةٍ، والنشاط إلى مؤشّرٍ يُقاس بالأداء. وهي تمثل في جوهرها المخرجات المباشرة للعمل اليومي التي يعتمد عليها سير العمليات المؤسسية واستقرارها.
لكنّ الأهداف التشغيلية في المفهوم الحديث لا تُقاس بعدد الأنشطة، بل بجودة المخرجات وأثرها. فالموظف الذي يُنجز مئة معاملةٍ في اليوم لا يُعدّ أكثر أداءً من زميله الذي يُنجز خمسين معاملةً بدقةٍ وجودةٍ تُقلّل الأخطاء وتُحسّن تجربة المستفيد. ولهذا بدأت أنظمة الأداء الخليجية — مثل النظام الإماراتي (EPMS) والدليل الإرشادي السعودي — تُؤكّد على أن “الإنجاز الكمي لا يُعتبر أداءً متميزًا ما لم يُحقق أثرًا نوعيًا”. فالأداء الفعّال ليس في السرعة وحدها، بل في الإتقان.
الأهداف التشغيلية الجيدة تُركّز إذن على النتائج المحققة ضمن نطاق الوظيفة، مثل “تقليص زمن المعاملة بنسبة 20٪”، أو “تحسين دقة التقارير التشغيلية بنسبة 95٪”، أو “رفع كفاءة استجابة النظام الفني للأعطال اليومية”. وهي تُستخدم عادةً في الوظائف التي تعتمد على إجراءاتٍ متكررةٍ ذات مخرجاتٍ واضحةٍ يمكن قياسها بسهولةٍ. فهذه الأهداف تُشكّل العمود الفقري لعدالة التقييم في الوظائف التنفيذية والإدارية الميدانية.
ومن الناحية الفلسفية، تُعبّر الأهداف التشغيلية عن بُعد “الإتقان” في العمل، وهو البعد الذي رسّخته تعاليمنا الإسلامية العميقة في قول النبي ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه». فالإتقان هنا ليس فقط في إكمال العمل، بل في تحسينه المستمرّ، وفي تحويل الأداء من مجرد إنجازٍ إلى إبداعٍ.
💡 ثانيًا: الأهداف التطويرية – من الأداء إلى التعلم
إذا كانت الأهداف التشغيلية تُعبّر عن الثبات في الأداء، فإنّ الأهداف التطويرية تُعبّر عن النمو والتحوّل في الكفاءة. فهي لا تَقيس “ما أُنجز الآن”، بل “ما سيتحسّن في المستقبل”. وهي بمثابة وعدٍ مستقبليٍّ بين الموظف والمؤسسة، بأنّ كل عامٍ يجب أن يكون أفضل من سابقه، وكل تجربةٍ يجب أن تُنتج معرفةً جديدةً. ولهذا فإنّ الأهداف التطويرية تُعتبر المحرّك الأساسي لدورة “التعلّم التنظيمي المستمرّ (Organizational Learning Cycle)”.
تُركّز هذه الأهداف على تنمية المهارات والكفاءات والقدرات التي تُمكّن الموظف من أداء عمله بكفاءةٍ أعلى أو الارتقاء إلى مهامٍ أكثر تعقيدًا. فهي لا تتحدث عن نتائجٍ كميةٍ، بل عن التحسّن في “القدرة على إنتاج نتائج أفضل”. ومن أمثلتها: “إتمام برنامج تدريبي في التحليل الإحصائي لتطوير مهارات إعداد التقارير”، أو “تحسين مهارة التواصل بين الإدارات عبر المشاركة في مشروعٍ مشتركٍ”، أو “تعزيز مهارات القيادة بالمشاركة من خلال قيادة فريقٍ تطوعيٍّ داخليٍّ”.
وتنبع أهمية هذه الأهداف من أنها تُحوّل نظام الأداء من “نظام محاسبة” إلى “نظام تمكين”. فبدلًا من أن يُركّز النظام على مراقبة الأخطاء فقط، يُصبح أداةً لتوجيه التطوير. وهذا التحوّل يُغيّر نظرة الموظف إلى التقييم، من كونه مصدر قلقٍ إلى كونه منصةً للتعلّم والنمو.
ومن زاويةٍ أعمق، تُعبّر الأهداف التطويرية عن فلسفةٍ مؤسسيةٍ تؤمن بأنّ الإنسان ليس أداةً للإنتاج فقط، بل هو رأس مالٍ قابلٌ للاستثمار المستمرّ. فكل ساعةٍ تُنفق في تطوير موظفٍ هي استثمارٌ في المستقبل المؤسسي. ولذلك نجد أن الأنظمة الخليجية المتقدمة، مثل نظام الأداء الحكومي الإماراتي، تُخصّص جزءًا من ميثاق الأداء للأهداف التطويرية، وتُلزم القادة بتحديد مسارات النمو المهني لموظفيهم كجزءٍ من مسؤولياتهم القيادية.
ومن الناحية النفسية، تُعزّز هذه الأهداف الشعور بالتحفيز الداخلي، لأنها تُعيد تعريف العلاقة بين “التقييم” و“التحسين”. فالإنسان حين يشعر أنّ المؤسسة تُقيّمه لتُطوّره لا لتُحاسبه فقط، يتحول خوفه إلى انتماءٍ، وجهده إلى طموحٍ. وهكذا يُصبح الأداء أداةً للتعلّم، والتعلّم أداةً للتحسين، والتحسين ثقافةً تُغذي المؤسسة كل عام.
🌱 ثالثًا: الأهداف السلوكية – من الكفاءة إلى القيم
النوع الثالث من الأهداف هو الأكثر عمقًا وتأثيرًا على المدى البعيد، وهو الأهداف السلوكية التي تُعبّر عن “كيف نؤدي العمل” لا “ماذا نؤدي”. إنها البوصلة الأخلاقية التي تُوجّه الأداء نحو القيم، لتضمن أن يتحقق الإنجاز في إطارٍ من السلوك المهني السليم. فالأداء الجيد بلا سلوكٍ جيدٍ يُفقد المؤسسة إنسانيتها ويُهدد استدامتها.
الأهداف السلوكية ترتبط عادةً بمفهوم “الجدارات السلوكية (Behavioral Competencies)” التي تُحدّدها المؤسسة ضمن إطارها العام. وتشمل مثلًا: التعاون، والتواصل، والمبادرة، وخدمة المتعاملين، والالتزام بالقيم المؤسسية، والانضباط، والعمل بروح الفريق. فهذه الجدارات لا تُقاس بالأرقام، بل بالملاحظات والتغذية الراجعة من القادة والزملاء والمستفيدين.
إنّ الهدف السلوكي الجيد هو الذي يُحوّل القيمة المؤسسية إلى ممارسةٍ يوميةٍ. فعندما تضع المؤسسة ضمن أهدافها “تعزيز ثقافة التعاون بين الإدارات” أو “رفع مستوى التواصل الفعّال مع الزملاء والعملاء”، فإنها لا تسعى إلى تحسين بيئة العمل فقط، بل إلى صناعة ثقافةٍ مؤسسيةٍ ناضجةٍ تقوم على الاحترام والثقة والتمكين. وهذا النوع من الأهداف يُعدّ الأكثر صعوبةً في القياس، لأنه يتعامل مع الأبعاد اللامادية للأداء، لكنّه أيضًا الأكثر تأثيرًا في المدى الطويل.
وقد أدركت الأنظمة الخليجية الحديثة هذا البعد، فضمّنته بوضوحٍ في أدوات التقييم الرسمية. ففي نظام الأداء الإماراتي (EPMS) مثلًا، يُشكّل بند “الجدارات السلوكية” ما نسبته 40٪ من التقييم النهائي، تأكيدًا على أنّ الأداء السلوكي لا يقل أهميةً عن الأداء المهني. أما في الدليل الإرشادي السعودي، فيُشدّد على أن الجدارات هي “القيم التي تحوّل الأداء إلى ممارسةٍ مسؤولةٍ”.
من الناحية الفلسفية، تُعبّر الأهداف السلوكية عن الوعي بأنّ النجاح الحقيقي ليس في تحقيق النتائج فحسب، بل في الطريقة التي نُحققها بها. فكل مؤسسةٍ تستطيع أن تُنجز، لكن ليست كل مؤسسةٍ تُنجز بشرفٍ وعدالةٍ واحترامٍ وإنسانيةٍ. والأهداف السلوكية هي التي تحفظ هذا التوازن بين الكفاءة والقيمة، بين الإنجاز والأخلاق.
🧭 رابعًا: التكامل بين الأنواع الثلاثة
الأداء المتكامل لا يُمكن أن يُقاس بنوعٍ واحدٍ من الأهداف. فالمؤسسة التي تُركّز على الأهداف التشغيلية فقط تُصبح آلةً منضبطةً بلا روح، والتي تُركّز على التطويرية فقط تُصبح مدرسةً بلا إنتاج، والتي تُركّز على السلوكية فقط تُصبح بيئةً مثاليةً بلا نتائج. أما المؤسسة الواعية فهي التي تُوازن بين الأنواع الثلاثة في كل ميثاق أداءٍ، بحيث يُعبّر كل هدفٍ عن أحد الأبعاد الثلاثة: الإنجاز، والنمو، والسلوك.
ومن الناحية العملية، يمكن أن نُصمّم ميثاق الأداء المثالي بحيث يتضمّن مثلًا:
-
50٪ من الأهداف التشغيلية (مرتبطة بالنتائج الكمية)،
-
30٪ من الأهداف التطويرية (مرتبطة بالنمو المهني)،
-
20٪ من الأهداف السلوكية (مرتبطة بالقيم والجدارات).
هذه النسبة ليست قانونًا، لكنها تُعبّر عن فلسفة التوازن بين النتائج والإنسان. فكلما نضجت المؤسسة، زاد اهتمامها بالبعد السلوكي لأنه يُمثّل ضمان الاستدامة.
🕊️ خامسًا: من التصنيف إلى الثقافة
حين تُصبح هذه الأنواع الثلاثة جزءًا من التفكير اليومي للمؤسسة، تتحول إلى ثقافةٍ متكاملةٍ للأداء. فالموظف يُفكّر في عمله بثلاث زوايا: “ماذا أنجزت؟”، “كيف تطوّرت؟”، و“كيف سلكت؟”. وعندما تتكرر هذه الأسئلة في كل تقييمٍ وكل اجتماعٍ وكل حوارٍ، يُصبح الأداء لغةً موحدةً تُعبّر عن وعيٍ مؤسسيٍّ متكاملٍ.
وهكذا، فإنّ أنواع الأهداف الوظيفية ليست تصنيفًا إداريًا جامدًا، بل هي خريطةُ وعيٍ تنظيميٍّ تُترجم العلاقة بين الفرد والمؤسسة، وبين الإنجاز والنمو والقيم. إنها المثلث الذهبي للأداء: الإنتاجية التي تُقاس، والقدرة التي تتطور، والسلوك الذي يُنضبط بالقيم. وعندما يكتمل هذا المثلث، تبلغ المؤسسة نضجها الحقيقي، لأنها لا تُنتج نتائج فحسب، بل تُنتج إنسانًا واعيًا يُجسّد القيم في العمل، ويُحوّل الهدف إلى أثرٍ، والأداء إلى معنى.
📊 تحويل المهام اليومية إلى أهداف قابلة للقياس
إنّ أحد أكثر التحديات التي تواجه الموظفين والمديرين على حدٍّ سواء هو كيفية الانتقال من المهام اليومية إلى الأهداف القابلة للقياس. فكثيرون يؤدون أعمالهم بكفاءةٍ يوميةٍ عالية، لكنهم لا يستطيعون التعبير عن تلك الكفاءة في شكل هدفٍ يُقاس ويُتابَع ويُراجَع. والسبب في ذلك أنّ العمل اليومي في ذاته لا يُعبّر بالضرورة عن الوعي بالأداء، تمامًا كما أن الحركة لا تعني التقدّم ما لم تُقَس باتجاهٍ واضحٍ وغايةٍ محددةٍ. ولهذا، فإنّ تحويل المهام إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس ليس مجرد إعادة صياغةٍ لغويةٍ، بل هو تحولٌ إدراكيٌّ في فهم العلاقة بين النشاط والنتيجة، بين الجهد والأثر، بين ما نفعله وما نُحدثه من تغييرٍ في البيئة المؤسسية.
لكي نُحوّل المهمة اليومية إلى هدفٍ قابلٍ للقياس، علينا أولًا أن نُفرّق بوضوحٍ بين “المهمة” و“الهدف”. فالمهمة هي وصفُ العمل الذي نقوم به، بينما الهدف هو نتيجةُ هذا العمل وتأثيره. فعلى سبيل المثال، “إعداد التقارير اليومية” مهمةٌ، أما “تحسين جودة التقارير اليومية بما يُسهم في دقة القرارات التشغيلية” فهو هدفٌ. الفرق بين الجملتين هو الفرق بين الفعل والغاية، بين التنفيذ والإدارة، بين أداء العمل والعمل بالأداء. فالذي يكتفي بالمهمة يُنجز ما يُطلب منه، أما الذي يفكر بالهدف فيُدير القيمة المضافة لعمله.
ولأنّ المهام اليومية تختلف من وظيفةٍ إلى أخرى، فإنّ عملية التحويل تتطلب منهجيةً تحليليةً دقيقةً تراعي طبيعة العمل. ويمكن تلخيص هذه المنهجية في خمس خطواتٍ مترابطةٍ تمثل سلسلة التفكير التحويلي من النشاط إلى الهدف:
1️⃣ تحليل المهمة: ما الذي أفعله فعلًا؟
الخطوة الأولى هي أن يُجيب الموظف بصدقٍ عن سؤالٍ بسيطٍ لكنه جوهريٍّ: “ما الذي أفعله كل يوم؟” هذه الإجابة ليست مجرد سردٍ للأنشطة، بل تحليلٌ دقيقٌ لماهية العمل، ومدخلاته، ومخرجاته، وعلاقته بالآخرين. فعلى سبيل المثال، موظف الموارد البشرية الذي يقول: “أُعدّ ملفات التوظيف” لم يُحدّد بعد قيمة عمله، لكن حين يقول: “أُعدّ ملفات التوظيف لضمان استيفاء الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة للقرار الإداري”، فإنه بدأ يُدرك أثر عمله في المنظومة. إنّ تحليل المهمة يعني فهمها في سياقها، لا في حدودها.
هذا الوعي التحليلي يُعدّ اللبنة الأولى في بناء الهدف، لأنه يُحوّل الرؤية من “أنا أنفّذ” إلى “أنا أُسهِم”. ومن هنا يمكن القول إنّ الموظف الذي لا يُحلّل مهامه لا يستطيع أن يُحوّلها إلى أهداف، لأنّ الهدف ليس ما نفعله، بل ما نُحدثه من أثرٍ من خلال ما نفعله.
2️⃣ تحديد الغاية: لماذا أقوم بهذه المهمة؟
الخطوة الثانية هي الانتقال من ماذا؟ إلى لماذا؟. فكل مهمةٍ في المؤسسة وُجدت لتخدم غايةً محددةً في النظام الأكبر. والموظف الذي يعرف “لماذا” يفعل ما يفعل هو أكثر وعيًا وأكثر قدرةً على التوجيه الذاتي. فعندما يُدرك مسؤول خدمة العملاء أنّ غاية مهمته ليست الرد على الاتصالات فقط، بل بناء تجربةٍ إيجابيةٍ تُعزّز رضا المتعاملين، فإنه يبدأ بكتابة هدفٍ يُعبّر عن الأثر لا عن الفعل: “تعزيز رضا المتعاملين عبر معالجة الطلبات بنسبة استجابةٍ لا تقل عن 95٪ خلال زمنٍ لا يتجاوز 3 دقائق”.
فكلما وضحت الغاية، صار من السهل تحديد الهدف، لأنّ الغاية تُقدّم “المعنى”، والمعنى هو الذي يُحوّل الجهد إلى قيمةٍ. إنّ هذا السؤال “لماذا؟” هو مفتاح التحول من الموظف التنفيذي إلى الموظف القائد لعمله.
3️⃣ تحديد المخرجات القابلة للقياس: كيف أعرف أنني أنجزت؟
الخطوة الثالثة تُعالج الجانب العملي في التحويل: أي تحديد المؤشرات التي تُثبت أن الهدف تحقق فعلاً. وهنا يُصبح السؤال المركزي: “ما الدليل على أنني أنجزت المهمة كما ينبغي؟” هذا الدليل هو الذي يُحوّل المهمة إلى هدفٍ قابلٍ للقياس. فإذا كان عملك إعداد التقارير، فالمؤشر هو “نسبة دقة البيانات”، وإذا كان عملك استقبال العملاء، فالمؤشر هو “نسبة رضا المستفيدين”، وإذا كان عملك في الصيانة، فالمؤشر هو “زمن معالجة البلاغات”.
فمن دون هذا المؤشر تبقى المهمة وصفًا لا يُمكن تقييمه بموضوعيةٍ. ولذلك تُشدّد الأنظمة الخليجية الحديثة على ضرورة أن تكون كل الأهداف مصحوبةً بمؤشرات أداءٍ واضحةٍ تُظهر مدى تحققها. فالمؤشر ليس ترفًا رقميًا، بل هو لغة العدالة التي تضمن التقييم العادل والشفافية في بيئة العمل.
4️⃣ صياغة الهدف بأسلوب SMART أو CLEAR
بعد فهم الغاية وتحديد المخرج، تأتي مرحلة الصياغة الاحترافية التي تُحوّل الفكرة إلى نصٍّ إداريٍّ واضحٍ. فبدلًا من أن تُكتب المهمة بصيغةٍ وصفيةٍ جامدةٍ مثل: “الرد على استفسارات العملاء”، تُصاغ بصيغةٍ هدفٍ ذكيٍّ محددٍ: “الرد على استفسارات العملاء خلال مدةٍ لا تتجاوز دقيقتين، مع تحقيق رضا بنسبة لا تقل عن 90٪ وفق نتائج استبيان نهاية الخدمة”. هنا تحوّل النشاط إلى هدفٍ قابلٍ للقياس من حيث الزمن والجودة والكمية والأثر.
ومن المهم أن يُكتب الهدف بلغةٍ إيجابيةٍ تُركّز على ما يُراد تحقيقه لا ما يُراد تجنّبه، فبدلًا من “تقليل الأخطاء في التقارير”، نكتب “تحسين دقة التقارير التشغيلية إلى 98٪”. هذه اللغة الإيجابية تُحفّز السلوك الإيجابي وتُوجّه الطاقة نحو البناء لا الخوف.
5️⃣ ربط الهدف بالمستوى المؤسسي الأعلى
الخطوة الأخيرة هي ربط الهدف الفردي بالنتيجة المؤسسية الكبرى التي يخدمها. فكل هدفٍ فرديٍّ يجب أن يُسهم في تحقيق هدفٍ تشغيليٍّ للإدارة، وكل هدفٍ تشغيليٍّ يجب أن يرتبط بهدفٍ استراتيجيٍّ للمؤسسة. هذا الترابط هو ما يُعرف بـ سلسلة الاتساق الرأسي (Vertical Alignment)، التي تُحوّل المؤسسة إلى منظومةٍ متناغمةٍ تسير في اتجاهٍ واحد.
فعلى سبيل المثال، عندما يضع موظف خدمة العملاء هدفه في “تحسين رضا المتعاملين بنسبة 90٪”، فإن هذا الهدف يرتبط مباشرةً بهدف الإدارة العامة في “رفع مؤشرات جودة الخدمات”، والذي بدوره يخدم الهدف الاستراتيجي للمؤسسة في “تعزيز ثقة المجتمع في خدماتها”. وبهذا يُصبح الأداء الفردي لبنةً في جدار الإنجاز المؤسسي الكبير.
💡 من النشاط إلى الوعي: التحول الإدراكي
تحويل المهام إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس ليس مجرّد عمليةٍ إجرائيةٍ، بل هو نقلةٌ في مستوى الوعي الإداري. فهو يُحوّل الموظف من “مُنفّذٍ” إلى “مُديرٍ لأدائه”، ومن “مُستجيبٍ” إلى “مُبادرٍ”، ومن “عاملٍ في النظام” إلى “شريكٍ في تطوير النظام”. فكل هدفٍ مكتوبٍ بوعيٍ يُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمؤسسة على أساس الشفافية والمساءلة المشتركة.
وفي هذا الإطار، يُصبح التحويل أداةً للتمكين، لا للرقابة. فالهدف الذي يُكتبه الموظف بنفسه، ويفهم معناه، ويرى أثره، يُصبح جزءًا من هويته المهنية. وهذا ما تُعبّر عنه الفلسفة الحديثة في إدارة الأداء بقولها: “الأداء لا يُدار، بل يُمكّن.” أي أن الغاية ليست أن تُسيطر المؤسسة على العمل، بل أن تُحرّر قدرات موظفيها لقيادة أدائهم بأنفسهم.
📈 البُعد المؤسسي للتحويل
من الناحية المؤسسية، تُعدّ هذه العملية محورًا أساسيًا في أنظمة إدارة الأداء الخليجية، لأنها تضمن توحيد لغة التقييم بين الإدارات المختلفة. فحين تُحوّل جميع الإدارات مهامها إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس باستخدام المنهج نفسه، تُصبح المؤسسة قادرةً على المقارنة والتحليل واكتشاف الفجوات وتخطيط التحسين المستمرّ. وهكذا يُصبح نظام الأداء ليس أداةً للمساءلة فقط، بل نظامًا للحوكمة والتعلّم التنظيمي.
وهذا ما أكدت عليه معايير EFQM للتميز المؤسسي وISO 30414 لإدارة رأس المال البشري، إذ نصت بوضوحٍ على أن قابلية القياس شرطٌ جوهريٌّ لبناء الشفافية والاستدامة في نظم الأداء. فالمؤسسة التي تعرف كيف تُحوّل مهامها إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس هي مؤسسةٌ تعرف كيف تُدير المعرفة، وكيف تُحوّل الخبرة إلى بياناتٍ، والبيانات إلى قراراتٍ، والقرارات إلى نتائجٍ.
🪞 خلاصة المحور
تحويل المهام اليومية إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس هو أرقى صور التفكير المؤسسي، لأنه يُحوّل “الفعل” إلى “معنى”، و“الجهد” إلى “قيمة”، و“العمل” إلى “وعي”. إنه التدريب العملي المستمرّ على التفكير بالنتائج لا بالأنشطة، وبالقيمة لا بالكلفة، وبالأثر لا بالإجراء. وكلما أتقنت المؤسسة هذه المهارة، اقتربت من جوهر العدالة التنظيمية، لأنها حينها لا تُقيّم الموظف بما يفعله، بل بما يُحدثه فعلاً. وهكذا يتحول الأداء إلى رحلةٍ من الوعي، تُقاس فيها الأعمال بالمغزى لا بالحركة، وبالأثر لا بالشكل.
🧮 نماذج الصياغة المتدرجة حسب المستويات الوظيفية
في أي مؤسسةٍ ناضجةٍ تسعى إلى العدالة والفعالية في نظام إدارة الأداء، لا يمكن النظر إلى الأهداف بصيغةٍ واحدةٍ تُطبّق على الجميع، لأنّ الأداء يتنوّع بتنوّع الأدوار، والمسؤوليات، ومستويات السلطة. فالموظف التنفيذي يقيس نجاحه بما يُنجزه من مهامٍ محددةٍ، والمشرف بما يُتابعه من نتائج فرق العمل، والمدير بما يُحققه من مؤشراتٍ استراتيجيةٍ أو تطويريةٍ، بينما القيادي الأعلى يُقاس بما يُحدثه من أثرٍ مستدامٍ في الثقافة المؤسسية والنتائج العامة.
ومن هنا، فإنّ صياغة الأهداف لا تُقاس فقط بدقتها اللغوية، بل أيضًا بمدى اتساقها مع المستوى الوظيفي الذي وُضعت له. إنّ كل مستوى في السلم الإداري يتطلّب زاويةَ رؤيةٍ مختلفةً للأداء، ومنهجيةَ تفكيرٍ متقدمةً تتناسب مع اتساع الأثر والمسؤولية.
إنّ جوهر التدرج في كتابة الأهداف يقوم على فكرةٍ فلسفيةٍ عميقةٍ مفادها أن القيمة الحقيقية للأداء لا تُحدّد بنوع العمل فحسب، بل بمستوى التأثير الذي يُحدثه. فكلما اتسع نطاق التأثير، تغيّر نوع الهدف وطريقة صياغته ومؤشر قياسه. ولذلك، يُمكن القول إنّ الأهداف تتدرّج عبر أربع طبقاتٍ رئيسيةٍ تتسق مع هيكل المؤسسة: التشغيلية، الإشرافية، الإدارية، والقيادية.
🌿 أولًا: المستوى التشغيلي – هدف الأداء المنفّذ
يُعتبر المستوى التشغيلي هو القاعدة الأوسع في الهرم التنظيمي، حيث يُمثّل الموظفون المنفّذون الذين يقومون بالمهام اليومية التي تُشكّل نبض العمليات في المؤسسة. هنا يكون التركيز على الإنجاز الكمي والنوعي المباشر، أي ما يتم إنجازه فعليًا خلال فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ.
وتُكتب الأهداف في هذا المستوى بطريقةٍ محددةٍ ودقيقةٍ، تُركّز على المخرجات القابلة للقياس، مثل:
-
“إتمام معالجة جميع طلبات العملاء خلال 24 ساعة بنسبة دقةٍ لا تقل عن 98٪.”
-
“إدخال البيانات التشغيلية اليومية في النظام الإلكتروني قبل نهاية كل يوم عمل.”
ويمتاز هذا المستوى بأنّ الهدف فيه مرتبطٌ بالنشاط المباشر الذي يقوم به الموظف بنفسه دون الحاجة إلى تفويضٍ أو اعتمادٍ كبيرٍ من الآخرين. وهنا يكون التركيز الأكبر على الكفاءة والإتقان والالتزام بالمعايير.
إلا أنّ التحدي الأكبر في هذا المستوى هو أن الموظف قد يظنّ أن الهدف هو مجرّد تنفيذٍ حرفيٍّ للتعليمات، بينما جوهر الهدف الحقيقي هو أن يُدرك الموظف أثر هذا التنفيذ في تحقيق الغايات المؤسسية الكبرى. فالموظف الذي يُدرك أنّ “إتمام المعاملات بسرعةٍ” يعني “تحسين رضا المستفيدين” سيؤدي عمله بروحٍ مختلفةٍ تمامًا. وهنا يتحول الهدف من تطبيق الإجراء إلى تحقيق القيمة.
⚙️ ثانيًا: المستوى الإشرافي – هدف الأداء المتابع
في هذا المستوى، ينتقل التركيز من التنفيذ إلى الإشراف والرقابة والتوجيه. فالمشرف لا يقوم بالعمل بنفسه، بل يضمن أن الآخرين يُنجزونه بكفاءةٍ واتساقٍ مع المعايير المطلوبة. ولذلك، فإنّ الأهداف الإشرافية تتعلق عادةً بجودة الأداء الجماعي، ومتابعة الالتزام بالخطط، ومعالجة الانحرافات التشغيلية.
وتُكتب الأهداف هنا بصياغةٍ تُظهر مسؤولية المشرف عن نتائج الفريق وليس عن أدائه الفردي، مثل:
-
“تحقيق التزام الفريق بإغلاق 95٪ من البلاغات التشغيلية ضمن المدة المحددة.”
-
“مراجعة التقارير الأسبوعية للتأكد من دقة البيانات بنسبة لا تقل عن 98٪، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.”
ويمتاز هذا المستوى بأنّ المؤشر لا يُقاس فقط بما يُنجزه المشرف شخصيًا، بل بما يُحققه الفريق الذي يُشرف عليه. وهنا تظهر مهارة القائد الإشرافي في التحفيز، والمتابعة، وبناء روح الفريق، لأنّ نجاحه يعتمد على مدى فعاليته في تمكين الآخرين من الإنجاز.
ويُعدّ هذا المستوى الجسر الذي يربط بين المنفّذين والإدارة، ولذلك فإنّ صياغة الأهداف فيه يجب أن تجمع بين وضوح القياس وديناميكية المتابعة. فالمشرف الناجح لا يُركّز على النتائج فقط، بل يُتابع المسار الذي يؤدي إليها، ويُقدّم التغذية الراجعة المستمرة لتحسين الأداء قبل أن يصل إلى مرحلة التقييم النهائي.
🧭 ثالثًا: المستوى الإداري – هدف الأداء التحليلي
في المستوى الإداري، يتّسع نطاق المسؤولية ليشمل التخطيط والتطوير وصنع القرار. فالمدير هنا لا يُتابع العمل فحسب، بل يُدير النظام الذي يُنتجه. ولذلك فإنّ أهدافه تتجاوز حدود العمليات اليومية لتشمل تحليل الأداء، وتطوير الإجراءات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان الاتساق المؤسسي بين الإدارات المختلفة.
وتُكتب الأهداف هنا بلغةٍ أكثر استراتيجيةً ودقةً، مثل:
-
“تحسين كفاءة استخدام الموارد التشغيلية عبر خفض زمن تنفيذ المشاريع بنسبة 15٪ خلال العام المالي.”
-
“تطوير نظام متابعة الأداء في الإدارة لضمان مواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف المؤسسية بنسبة 100٪.”
يمتاز هذا المستوى بأنّ الهدف لم يعد يصف ما يجب فعله، بل ما يجب تحسينه. فالمدير الناجح لا يُكرّر ما هو موجود، بل يُعيد ابتكاره. وهو يُقاس بقدرته على إدارة التغيير، والتعامل مع الغموض، وصنع قراراتٍ قائمةٍ على الأدلة والبيانات.
ولأنّ هذا المستوى يُشكّل الطبقة الوسطى في القيادة، فهو يتحمّل مسؤولية ترجمة الاستراتيجيات إلى واقعٍ تشغيليٍّ قابلٍ للقياس. وهنا يصبح المؤشر ليس فقط في الأداء ذاته، بل في التحسين المستمرّ للأداء. أي أنّ الهدف الإداري الناجح لا يكتفي بتحقيق الأرقام، بل يُحوّل المؤسسة إلى منظمةٍ متعلّمةٍ قادرةٍ على التطوّر الذاتي.
🏛 رابعًا: المستوى القيادي – هدف الأداء التحويلي
في القمة، حيث تتخذ القرارات الاستراتيجية وتُحدَّد الاتجاهات الكبرى، يتغيّر معنى الهدف جذريًا. فالقائد لا يُقاس بما يُنجزه بيديه، بل بما يُلهم الآخرين لإنجازه، وبما يُحدثه من تحوّلٍ في الثقافة المؤسسية والنتائج بعيدة المدى. وهنا يُصبح الهدف في جوهره “هدفَ أثرٍ” لا “هدفَ فعلٍ”، لأنّ القيادي يُدير المعنى قبل أن يُدير العملية.
تُكتب الأهداف القيادية بلغةٍ استراتيجيةٍ عميقةٍ تُعبّر عن التحوّل والتأثير، مثل:
-
“تعزيز ثقافة الأداء القائم على النتائج من خلال تطبيق نظام إدارة الأداء الإلكتروني وربطه بخطط التحفيز خلال السنة المالية الحالية.”
-
“رفع مستوى الجاهزية المؤسسية لتحقيق رؤية الوزارة 2030 عبر تطوير إطارٍ متكاملٍ للجدارات القيادية وربطه بخطط التعاقب الوظيفي.”
في هذا المستوى، لا يُقاس القائد بعدد الأهداف المحققة، بل بنوعية التغيير الذي أحدثه. فالقائد الفعّال هو الذي يترك بصمةً مؤسسيةً تُستمر بعده، ويُحوّل الأداء من التزامٍ بالأنظمة إلى التزامٍ بالمعنى. ولهذا فإنّ مؤشرات الأداء القيادي تُركّز على القيم الاستراتيجية مثل الاستدامة، والتمكين، والابتكار، وبناء القدرات المؤسسية.
💡 البعد الفلسفي للتدرّج
وراء هذا التدرج في الصياغة تكمن فلسفةٌ عميقةٌ مفادها أن الأداء لا يُقاس بكمية العمل فقط، بل بمستوى الوعي المؤسسي الذي يُنتجه. فكلما صعد الموظف في السلم الإداري، تغيّر نوع الهدف من “الإنجاز” إلى “التمكين”، ومن “التحقيق” إلى “التحويل”. وهذا يعني أن المؤسسة التي تُطبّق مبدأ التدرج في كتابة الأهداف هي مؤسسةٌ تُدير النمو المعرفي قبل أن تُدير العمل.
ومن هنا نجد أن بعض الأنظمة الخليجية، مثل نظام إدارة الأداء الإماراتي (EPMS)، تُفرّق بوضوحٍ بين “الأهداف المؤسسية”، و“الأهداف الوظيفية”، و“الأهداف السلوكية”، وتُحدّد لكل مستوىٍ أوزانًا مختلفةً داخل التقييم النهائي. كذلك نجد في الدليل الإرشادي السعودي للائحة الأداء الوظيفي أن صياغة الأهداف تُراعى فيها طبيعة الوظيفة ومستوى المسؤولية لضمان العدالة في المقارنة بين العاملين.
إنّ هذا التدرج لا يُسهم فقط في العدالة، بل في تحقيق الشفافية والتكامل المؤسسي. فكل موظفٍ يعرف ما يُنتظر منه بدقة، وكل قائدٍ يعرف كيف يُقاس أثره، وكل إدارةٍ تعرف كيف تُترجم أهدافها إلى نتائجٍ قابلةٍ للمتابعة. وهكذا تُصبح المؤسسة كائنًا حيًا يتنفس الأهداف ويُطوّرها باستمرارٍ، فلا يبقى الهدف وثيقةً إداريةً جامدةً، بل يتحول إلى نبضٍ مؤسسيٍّ متجددٍ.
📈 من النماذج إلى التطبيق
تطبيق هذا التدرج يتطلب تدريبًا منهجيًا لجميع المستويات الوظيفية على مهارة كتابة الأهداف المناسبة لمستواهم. فالكثير من حالات الإخفاق في أنظمة الأداء لا تعود إلى ضعف النظام ذاته، بل إلى ضعف الفهم لمبدأ التدرج. فحين يكتب الموظف التنفيذي هدفًا استراتيجيًا، أو يكتب المدير هدفًا تشغيليًا بحتًا، تضيع المعايير ويختل ميزان العدالة في التقييم. ولهذا ينبغي أن تُنشئ المؤسسات دليلًا داخليًا لصياغة الأهداف حسب المستويات، يتضمن نماذج عملية، ومؤشرات قياس، وأمثلة واقعية، بحيث تُصبح كتابة الأهداف ممارسةً موحّدةً ومفهومةً.
🪞 خلاصة المحور
إنّ نماذج الصياغة المتدرجة ليست تصنيفًا إداريًا فقط، بل هي مرآةٌ لنضج المؤسسة. فكلما ازداد وعي الموظفين والمديرين بهذه الفوارق، أصبحت المؤسسة أكثر قدرةً على تحويل الأداء إلى نظامٍ عادلٍ ومتكاملٍ يُحفّز الجميع على التطور لا التنافس السلبي. فالموظف المنفّذ يجد نفسه مقدَّرًا بإنجازه، والمشرف يُكافَأ على تطوير فريقه، والمدير يُقيَّم على تحسين النظام، والقائد يُكرَّم على بناء الثقافة. وهكذا يتحقق الوعي المؤسسي بأنّ كل مستوىٍ هو حلقةٌ في سلسلة الإنجاز، وأنّ التميّز المؤسسي لا يُبنى على أهدافٍ متشابهةٍ، بل على أهدافٍ متكاملةٍ تُعبّر عن اختلاف الأدوار ووحدة الاتجاه.
🧭 أخطاء شائعة في كتابة الأهداف وكيفية تصحيحها
إنّ كتابة الأهداف الوظيفية هي في ظاهرها عملٌ بسيطٌ، لكنها في حقيقتها عمليةٌ عقليةٌ معقدةٌ تجمع بين التفكير الاستراتيجي، والفهم العميق لطبيعة العمل، والقدرة على التعبير الدقيق. ولهذا السبب، فإنّ كثيرًا من المؤسسات تقع في فخّ الصياغة الخاطئة للأهداف، مما يؤدي إلى ضعفٍ في التطبيق، وغموضٍ في التقييم، وانحرافٍ في العدالة المؤسسية. إنّ الهدف غير الدقيق أشبه ببوصلـةٍ بلا إبرة، يقود الجهود في كل اتجاهٍ ولا يصل إلى غايةٍ محددةٍ. ولذلك فإنّ تحليل الأخطاء الشائعة في كتابة الأهداف يُعدّ ضرورةً علميةً ومهنيةً، لأنه يُساعد المؤسسات على الانتقال من “كتابة النصوص” إلى “بناء الوعي”.
في هذا المحور، نُحلّل أبرز الأخطاء التي تتكرر في بيئات العمل عند إعداد الأهداف الوظيفية، ونُقدّم المقابل الصحيح لها، لنُحوّل الأخطاء إلى فرصٍ للتعلّم والتحسين.
🌿 أولًا: الخلط بين المهمة والهدف
يُعدّ هذا الخطأ من أكثر الأخطاء شيوعًا في المؤسسات، وهو أن يكتب الموظف في خانة الأهداف ما هو في الحقيقة وصفٌ لمهمةٍ أو نشاطٍ وليس هدفًا. فمثلًا:
❌ “الرد على استفسارات العملاء.”
هذه ليست هدفًا، لأنها تُعبّر عن نشاطٍ روتينيٍّ مستمرٍّ، لا يمكن قياسه بنتيجةٍ محددةٍ.
بينما الصياغة الصحيحة هي:
✅ “الرد على استفسارات العملاء خلال مدةٍ لا تتجاوز دقيقتين، وبنسبة رضاٍ لا تقل عن 95٪ وفق استبيان المتعاملين.”
الفرق بين الصيغتين هو الفرق بين “الفعل” و“الأثر”. فالمهمة تُخبرنا ماذا نفعل، أما الهدف فيُخبرنا لماذا نفعل ومتى وبأي نتيجةٍ نُنجز. ومن الناحية الفكرية، فإنّ هذا الخطأ يعكس غياب الوعي بالتحول من ثقافة التنفيذ إلى ثقافة النتائج. فالموظف الذي يكتب مهمته كهدفٍ يُعبّر عن عقلٍ مبرمجٍ على “القيام بما يُطلب منه”، بينما المطلوب في إدارة الأداء الحديثة هو عقلٌ يفكر بـ“تحقيق ما يُؤثر”.
ولتصحيح هذا الخطأ، على القائد أن يُدرب موظفيه على طرح سؤالٍ بسيطٍ قبل كتابة أي هدفٍ: “ما الذي سيختلف بعد أن أنجز هذه المهمة؟” — والإجابة هي الهدف الحقيقي.
⚙️ ثانيًا: الغموض في الصياغة وضعف الوضوح المفاهيمي
كثير من الأهداف تُكتب بلغةٍ فضفاضةٍ تُعطي انطباعًا جميلًا لكنها لا تُقدّم أي وضوحٍ عمليٍّ. فعبارات مثل “تحسين الأداء العام”، أو “رفع جودة الخدمات”، أو “تعزيز روح الفريق”، تبدو إيجابيةً لكنها غامضةٌ وغير قابلةٍ للقياس.
فالتحسين كلمةٌ واسعةٌ بلا معيار، والجودة مفهومٌ نسبيٌّ ما لم يُحدّد بمؤشرٍ واضحٍ، وروح الفريق شعورٌ لا يُقاس إلا عبر أدواتٍ نوعيةٍ محددةٍ. هذا الغموض يُنتج أهدافًا جميلةً على الورق، لكنها عاجزةٌ عن توجيه الفعل المؤسسي.
والصحيح أن تُحوّل الكلمات العامة إلى معايير محددةٍ، مثل:
✅ “رفع جودة الخدمات من خلال تقليل الأخطاء التشغيلية بنسبة 20٪ خلال الربع الأول.”
✅ “تعزيز روح الفريق من خلال تنفيذ مبادرتين جماعيتين خلال السنة وقياس أثرهما في رضا العاملين.”
الوضوح هنا لا يُقلّل من جمال اللغة، بل يُحوّلها إلى أداةٍ للإنجاز. فالأداء لا يحتاج إلى عباراتٍ بلاغيةٍ، بل إلى لغةٍ عمليةٍ دقيقةٍ تُحدّد الاتجاه والمسؤولية والزمن والأثر.
🧩 ثالثًا: تعدد الأهداف في جملةٍ واحدة
من الأخطاء المتكررة أن يُكتب أكثر من هدفٍ في جملةٍ واحدةٍ، مثل:
❌ “رفع رضا المتعاملين، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأخطاء التشغيلية.”
وهذا خطأ لأنّ الجملة الواحدة تُصبح ثلاثة أهدافٍ بلا وضوحٍ في الأولوية ولا في القياس. والنتيجة أن التقييم يصبح مستحيلًا، لأنّ كل طرفٍ في عملية التقييم قد يختار جانبًا مختلفًا للتركيز عليه.
القاعدة العلمية تقول:
“الهدف الواحد = مؤشر واحد = نتيجة واحدة.”
ولذلك يجب أن تُفصل الأهداف المتعددة إلى جملٍ مستقلةٍ، بحيث يُصبح كل هدفٍ قائمًا بذاته، وله مؤشرٌ خاصٌّ به، ومسؤولٌ محددٌ عن تحقيقه.
✅ “رفع رضا المتعاملين بنسبة 10٪ خلال الربع الثالث.”
✅ “تقليل الأخطاء التشغيلية في التقارير اليومية بنسبة 20٪.”
الانضباط في عدد الأهداف لا يعني التبسيط، بل هو ما يُسمّى في منهجيات الأداء الحديثة التركيز الاستراتيجي (Strategic Focus)، أي أن تُوجّه الطاقة نحو ما يُحدث الأثر الأكبر لا نحو ما يُرضي كثرة البنود.
💡 رابعًا: غياب القياس الكمي أو النوعي
من أكثر ما يُضعف الهدف أن يُكتب بلا معيارٍ للقياس، وهو ما يجعل تحقيقه مسألةً انطباعيةً لا موضوعيةً. فعبارة مثل:
❌ “تحسين التواصل الداخلي.”
لا يمكن قياسها، لأننا لا نعرف ما المقصود بـ “تحسين” ولا كيف سنعرف أنه تحقق.
بينما الصياغة الصحيحة ستكون:
✅ “رفع مستوى التواصل الداخلي من خلال إصدار نشراتٍ أسبوعيةٍ داخليةٍ منتظمةٍ بنسبة التزامٍ لا تقل عن 90٪ خلال العام.”
الفرق أنّ الهدف الآن قابلٌ للقياس من خلال عدد النشرات، وانتظامها، ونسبة الالتزام بالجدول الزمني.
ومن الجدير بالذكر أنّ القياس لا يعني الأرقام فقط، فهناك قياساتٌ نوعيةٌ وسلوكيةٌ مثل: رضا المستفيدين، أو جودة التقارير، أو مستوى الالتزام بالقيم المؤسسية. المهم أن تكون هناك أداةٌ موضوعيةٌ تُظهر إن كان الهدف تحقق أم لا.
وقد شدّد الدليل الإرشادي السعودي للائحة الأداء الوظيفي على أنّ “الهدف غير القابل للقياس يُعتبر غير صالحٍ للتقييم”، لأنّ العدالة المؤسسية لا تقوم إلا على معايير يمكن التحقق منها.
🧭 خامسًا: عدم الربط بين الهدف ودور الوظيفة
أحد الأخطاء الجوهرية هو كتابة أهدافٍ لا علاقة لها بالمهام الأساسية للوظيفة، إما لأنها منسوخةٌ من نماذجٍ عامةٍ، أو لأنها كُتبت لإرضاء التقييم لا لتحقيق النتيجة. فمثلاً:
❌ موظف الشؤون المالية يكتب هدفًا: “تحسين رضا المتعاملين في مركز الاستقبال.”
بينما دوره الأساسي يتركز في ضبط الحسابات والتقارير المالية. هذا الخطأ يُضعف من عدالة التقييم، لأنه يُقارن بين أداءٍ في مجالٍ لا يخص الوظيفة أصلاً.
القاعدة الجوهرية هنا هي أنّ كل هدفٍ يجب أن يُعبّر عن القيمة الجوهرية للوظيفة. فالوظيفة المالية تُقاس بدقة البيانات المالية، ووظيفة الموارد البشرية تُقاس بتطوير الجدارات أو تحسين دورة التوظيف، ووظيفة خدمة العملاء تُقاس بسرعة الاستجابة وجودة المعالجة.
إنّ الخلط بين الهدف والدور الوظيفي يُفقد النظام معناه، ويحوّل الأداء إلى عمليةٍ شكليةٍ لا تُعبّر عن القيمة الحقيقية للموظف.
⚖️ سادسًا: عدم تحديد المسؤولية أو الزمن
الهدف الذي لا يُحدّد من المسؤول عن تحقيقه، أو متى يجب إنجازه، يفقد نصف معناه. فالأداء مرتبطٌ بالزمن، والمسؤولية شرطٌ للمساءلة. لذلك يجب أن تتضمن كل صياغةٍ هدفيةٍ بُعدين أساسيين: من؟ ومتى؟.
✅ “إعداد تقرير الأداء الشهري من قِبل إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر.”
الزمن هنا ليس تفصيلًا، بل هو أداة ضبطٍ للسلوك الإداري، لأنه يُحوّل النية إلى التزامٍ فعليٍّ. فكل هدفٍ بلا زمنٍ مفتوحٌ على التسويف، وكل هدفٍ بلا مسؤولٍ لا يُحاسَب عليه أحد. ولهذا فإنّ الأنظمة الخليجية الحديثة تُشدّد على تضمين بُعد الزمن في كل الأهداف لضمان استمرارية المتابعة.
🧠 سابعًا: غياب العلاقة بين الهدف والمؤشرات المؤسسية الكبرى
في كثيرٍ من المؤسسات، تُكتب الأهداف الفردية بمعزلٍ عن الأهداف المؤسسية العليا، مما يُفقد النظام اتساقه الداخلي. فحين لا يعرف الموظف كيف يُسهم هدفه في تحقيق رؤية المؤسسة، يشعر أنّ عمله منفصلٌ عن الصورة الكبرى. وهذا ما يُعرف في أدبيات الأداء بمشكلة “انفصال الأهداف (Goal Misalignment)”.
ولتصحيح ذلك، يجب أن يُربط كل هدفٍ فرديٍّ بهدفٍ أعلى منه وفق تسلسلٍ منطقيٍّ واضحٍ. فهدف الموظف في “رفع نسبة رضا العملاء” يجب أن يخدم هدف الإدارة في “تحسين جودة الخدمات”، والذي بدوره يخدم الهدف المؤسسي في “تعزيز ثقة الجمهور”. هذا الترابط يُشكّل ما يُعرف بـ شجرة الأهداف (Goals Tree) التي تُحوّل المؤسسة إلى منظومةٍ متكاملةٍ تتحدث لغةً واحدةً.
🌍 ثامنًا: النسخ والتكرار دون فهمٍ أو تخصيص
من أكثر الممارسات ضررًا في أنظمة الأداء أن يتم نسخ الأهداف من زميلٍ إلى آخر دون مراعاةٍ لاختلاف طبيعة العمل أو حجم المسؤوليات. هذا السلوك يُفقد الهدف خصوصيته، ويحوّل نظام الأداء إلى روتينٍ إداريٍّ فاقدٍ للمعنى.
فكل وظيفةٍ هي عالمٌ فريدٌ من المهام والنتائج، وكل موظفٍ يمتلك قدراتٍ وسياقًا خاصًا يجب أن يُترجم في الأهداف. ولهذا، فإنّ كتابة الأهداف ليست عملية “ملء نماذج”، بل هي عملية وعيٍ وفهمٍ وتحليلٍ. وعلى القادة أن يدرّبوا موظفيهم على صياغة أهدافٍ تعبّر عنهم، لأنّ الهدف الشخصي هو الذي يُحفّز الالتزام الداخلي.
📈 تاسعًا: الاهتمام بالشكل أكثر من الجوهر
كثير من المؤسسات تهتم بأن تكون الأهداف مكتوبةً وفق النماذج الرسمية دون أن تُدقّق في معناها ومحتواها. فيتحوّل الهدف إلى نصٍّ جميلٍ بلا روحٍ، وتُصبح عملية التقييم شكليةً لا تُنتج تطويرًا. إنّ الهدف في جوهره ليس وثيقةً للملف الوظيفي، بل هو أداة لتحسين الأداء وتوجيه الجهد.
ولذلك فإنّ الجودة الحقيقية في كتابة الأهداف لا تقاس بجمال الصياغة أو التنسيق، بل بوضوح الفكرة، ودقة المؤشر، وقوة الارتباط بالنتيجة. فالأداء الحقيقي يُبنى على الجوهر لا على الشكل.
🪞 عاشرًا: إغفال المراجعة الدورية للأهداف
الأهداف ليست نصوصًا جامدةً تُكتب في بداية العام وتُنسى حتى نهايته. بل هي كائنٌ حيٌّ يتطور ويتفاعل مع المتغيرات. إنّ تجاهل مراجعة الأهداف بشكلٍ دوريٍّ يُضعف فاعليتها ويُفقد النظام مرونته. فالمؤسسة الذكية هي التي تراجع أهدافها في منتصف الدورة، وتُحدثها وفق المستجدات، وتُضيف أهدافًا جديدةً إذا تطلّب الواقع ذلك.
وقد نصّت الأنظمة الخليجية الحديثة على ما يُعرف بـ “حوار الأداء النصف سنوي” الذي يُعدّ أداةً لتصحيح مسار الأهداف وضمان اتساقها مع التحولات المستمرة في بيئة العمل. فالمراجعة ليست تصحيحًا للأخطاء فقط، بل هي تعلّمٌ مستمرٌّ يُحوّل الأداء إلى عملية تحسينٍ متواصلةٍ.
🔍 خلاصة المحور
إنّ الأخطاء في كتابة الأهداف ليست مجرد أخطاءٍ إجرائيةٍ، بل هي مؤشراتٌ على ضعفٍ في الفهم المؤسسي لطبيعة الأداء ذاته. فحين تُكتب الأهداف بسطحيةٍ، يُصبح الأداء شكليًا، وحين تُكتب بوعيٍ، يُصبح الأداء وسيلةً للتطوير والتحفيز والتعلّم. إنّ الهدف ليس سطرًا في نموذجٍ إداريٍّ، بل هو اتفاقٌ فكريٌّ وسلوكيٌّ بين الموظف والمؤسسة على ما يعنيه النجاح وكيف يُقاس.
وكلما قلّت هذه الأخطاء، زاد نضج المؤسسة في إدارة رأس مالها البشري، لأنّ جودة الأهداف هي المرايا التي تُظهر جودة التفكير. والمؤسسة التي تُتقن كتابة الأهداف تُتقن بناء المستقبل، لأنها تُحوّل الكلمات إلى اتجاهٍ، والاتجاه إلى إنجازٍ، والإنجاز إلى أثرٍ مستدامٍ.
💡 الأهداف في الأنظمة الخليجية الرسمية: من الدليل الإرشادي السعودي إلى النظام الإماراتي
إنّ دراسة الأهداف في الأنظمة الخليجية الرسمية لإدارة الأداء تكشف عن رحلةٍ فكريةٍ وتنظيميةٍ متقدمة تعكس وعيًا مؤسسيًا متزايدًا بأهمية بناء منظوماتٍ متكاملةٍ لإدارة رأس المال البشري على أساسٍ من العدالة، والتحفيز، والمساءلة، والتنمية المستدامة. لم يعد الهدف الوظيفي مجرّد بندٍ إداريٍّ في نموذج تقييمٍ سنويٍّ، بل أصبح أداةً استراتيجيةً لربط أداء الفرد بأداء المؤسسة، ووسيلةً لتحويل الرؤية الوطنية إلى ممارساتٍ ميدانيةٍ تُقاس بالأثر والنتائج.
ويُمكن القول إنّ الأنظمة الخليجية الحديثة، وعلى رأسها النظام السعودي ممثلًا في الدليل الإرشادي للائحة الأداء الوظيفي، والنظام الإماراتي ممثلًا في نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية (EPMS)، قد تجاوزت مرحلة "إدارة الأداء" بمعناها التقليدي، إلى مرحلةٍ أكثر نضجًا تتجسد في ما يمكن تسميته بـ "حوكمة الأداء البشري Human Performance Governance". هذه المرحلة تُمثل نقطة التحول التي انتقل فيها الأداء من التقييم إلى التمكين، ومن الحكم إلى التعلم، ومن الانضباط الخارجي إلى الانضباط الذاتي الواعي.
🏛 أولًا: النظام السعودي – الدليل الإرشادي للائحة الأداء الوظيفي
يُعدّ الدليل الإرشادي للائحة الأداء الوظيفي في المملكة العربية السعودية وثيقةً تنظيميةً محوريةً صدرت لتوحيد فهم الجهات الحكومية والخاصة لطبيعة الأهداف وأدوات التقييم وفق فلسفةٍ جديدةٍ ترتكز على الشفافية، والموضوعية، والتطوير المستمرّ. وقد شكّل هذا الدليل نقلةً نوعيةً في ثقافة الأداء، لأنه نقل الممارسات من مجرد تسجيل الدرجات إلى إدارة رحلة الإنجاز طوال العام.
في بنية هذا النظام، تتضح رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء منظومةٍ متكاملةٍ للتميّز في الأداء الوظيفي، تجعل من الأهداف الوظيفية حجر الزاوية في قياس الإنتاجية وتحفيز الكفاءة وتحديد الاحتياجات التدريبية.
وينطلق الدليل السعودي من مبدأٍ واضحٍ مفاده أنّ “كل موظفٍ يجب أن يعرف ما هو متوقعٌ منه بدقةٍ، وكيف سيُقاس أداؤه، ومتى سيتم تقييمه، وعلى أي أساسٍ ستُبنى قرارات التطوير أو المكافأة أو الترقي”. هذا الوضوح يُعتبر جوهر العدالة في إدارة الأداء، ويُحوّل العلاقة بين الموظف والمؤسسة إلى علاقةٍ قائمةٍ على التفاهم والاتفاق لا على المفاجآت السنوية.
من الناحية المنهجية، يُحدّد الدليل السعودي أن الأهداف يجب أن تكون:
1️⃣ مرتبطةً بطبيعة الوظيفة ومهامها الأساسية.
2️⃣ قابلةً للقياس عبر مؤشراتٍ كميةٍ أو نوعيةٍ دقيقةٍ.
3️⃣ قابلةً للتحقيق ضمن الموارد والإمكانات المتاحة.
4️⃣ محددةً زمنيًا لتحقيق المتابعة الدورية.
5️⃣ مرتبطةً بمخرجاتٍ واضحةٍ تعكس الأثر الحقيقي على الأداء المؤسسي.
وقد أكّد الدليل على أنّ صياغة الأهداف ليست مهمةً إداريةً شكليةً، بل هي شراكةٌ بين الموظف ورئيسه المباشر تُناقش في بداية الدورة السنوية، وتُراجع في منتصفها، وتُقيّم في نهايتها ضمن إطارٍ من الحوار والتغذية الراجعة.
كما شدّد الدليل على ضرورة أن تُقسّم الأهداف إلى نوعين رئيسيين:
-
أهدافٍ كمّيةٍ وتشغيليةٍ تُقاس بمؤشراتٍ رقميةٍ مرتبطةٍ بالإنتاجية والكفاءة.
-
وأهدافٍ نوعيةٍ وسلوكيةٍ تُقاس بالملاحظة والتغذية الراجعة والسلوك المؤسسي.
ويُعدّ هذا التقسيم أحد أبرز مظاهر النضج في النظام السعودي، لأنه يدمج بين الأداء المهني والأداء القيمي في معادلةٍ واحدةٍ تُحقق العدالة الشاملة.
أما على مستوى التطبيق، فقد تضمّن الدليل مجموعةً من النماذج العملية التي تُساعد الجهات الحكومية على تحويل المهام إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس، مع أمثلةٍ واقعيةٍ من بيئات العمل المختلفة. وقد ساهم هذا التوجّه في تعزيز قدرة المديرين على صياغة الأهداف بوضوحٍ ودقةٍ، ما انعكس على جودة عمليات التقييم في نهاية الدورة.
ومن الزاوية الفلسفية، يُجسّد هذا النظام فكر الحوكمة الإدارية في أبهى صوره، لأنه يُحوّل الأداء من عملٍ فرديٍّ إلى منظومةٍ مترابطةٍ من المسؤوليات المشتركة. فالموظف يُدير هدفه، والمشرف يُتابع التنفيذ، والمدير يُوجّه المسار، والقيادة تُقيّم الأثر في ضوء الأهداف الاستراتيجية العليا. وبهذا يُصبح الأداء لغةً مؤسسيةً مشتركةً تُنظّم العلاقة بين المستويات الإدارية وتُرسّخ ثقافة العمل بالنتائج.
🇦🇪 ثانيًا: النظام الإماراتي – نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية (EPMS)
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تميّز نظام إدارة الأداء الحكومي (EPMS) بكونه أحد أكثر النماذج الخليجية تكاملًا وتطورًا، إذ يجمع بين المنهج التحليلي الإداري والمنهج التحفيزي الإنساني في إدارة الأداء. وقد أسّست الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية هذا النظام ليكون أداةً استراتيجيةً لتمكين الموظفين من فهم أدوارهم وتطوير قدراتهم وتحقيق التميز في الأداء الحكومي على مستوى الدولة.
يُبنى النظام الإماراتي على ثلاث مراحلٍ رئيسيةٍ تشكّل دورة الأداء الكاملة:
1️⃣ مرحلة تخطيط الأداء (Performance Planning)
2️⃣ مرحلة مراجعة الأداء (Performance Review)
3️⃣ مرحلة تقييم الأداء (Performance Appraisal)
وفي المرحلة الأولى، تُحدّد الأهداف بالتشارك بين الموظف والرئيس المباشر عبر ميثاق الأداء (Performance Agreement)، وهو وثيقةٌ تُعبّر عن الالتزام المتبادل بين الطرفين لتحقيق النتائج المطلوبة. ويُراعى في صياغة الأهداف أن تكون متوازنةً بين ثلاثة أبعادٍ رئيسيةٍ:
-
الأهداف الوظيفية التي تُعبّر عن المهام الأساسية.
-
الأهداف التطويرية التي تُعزّز النمو المهني والجدارات.
-
الأهداف السلوكية التي تُترجم القيم المؤسسية في الأداء اليومي.
وقد جعل النظام الإماراتي من “الجدارات السلوكية (Behavioral Competencies)” محورًا أساسيًا في عملية التقييم، بحيث تشكّل نسبةً معتبرةً من الدرجة النهائية للأداء، إدراكًا منه بأنّ الأداء لا يتحقق بالكفاءة الفنية فقط، بل بالسلوك المؤسسي الذي يعكس القيم والهوية الوطنية.
ومن الناحية التنفيذية، يعتمد النظام الإماراتي على منصةٍ إلكترونيةٍ متكاملةٍ تُتيح للموظفين والمديرين إدارة دورة الأداء كاملةً رقميًا — من وضع الأهداف إلى اعتماد التقييم النهائي — مما يُعزز الشفافية، ويُسهل المتابعة، ويُقلل الأخطاء البشرية. وقد ساهم هذا التحول الرقمي في تحويل إدارة الأداء من عمليةٍ سنويةٍ إلى منظومةٍ مستمرةٍ للتغذية الراجعة والتطوير الذاتي.
أما من حيث الفلسفة الإدارية، فإنّ النظام الإماراتي ينطلق من رؤيةٍ عميقةٍ مفادها أنّ “الأداء هو رحلة تمكينٍ إنسانيةٍ لا عملية مراقبةٍ بيروقراطيةٍ”. ولذلك، فإنّ كل مرحلةٍ في النظام تتضمن مساحةً للحوار والتعلّم والتغذية الراجعة. ففي منتصف الدورة، يُجرى اجتماع مراجعة الأداء النصف سنوي لمناقشة التحديات وتعديل الأهداف إذا تطلب الأمر، مما يُجسّد المرونة المؤسسية والتعلّم المستمرّ في أبهى صوره.
ومن اللافت أنّ النظام الإماراتي لم يقف عند حدود إدارة الأداء الفردي، بل ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي عبر مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) على مستوى الجهة، ضمن نموذجٍ يُعرف بـ Cascading Objectives، أي “تسلسل الأهداف” من المستوى الوطني إلى المؤسسي إلى الفردي. وبذلك يُصبح كل هدفٍ فرديٍّ لبنةً في بناء الاستراتيجية الوطنية الكبرى، مما يُحوّل الأداء إلى منظومةٍ وطنيةٍ متكاملةٍ تعمل بروحٍ واحدةٍ وإن اختلفت مواقعها.
🌍 ثالثًا: التحليل المقارن بين النظامين السعودي والإماراتي
رغم أن النظامين ينتميان إلى بيئةٍ خليجيةٍ واحدةٍ، فإنّ لكلٍّ منهما خصوصيةٌ منهجيةٌ وفلسفيةٌ تُثري التجربة الإقليمية في إدارة الأداء.
-
فالنظام السعودي يُركّز على توحيد المفاهيم التنظيمية وضبط العدالة في التطبيق، مما يجعله مرجعًا في المعايير والإجراءات.
-
بينما النظام الإماراتي يُركّز على تحفيز الموظف وإطلاق طاقاته الذاتية نحو التميز، مما يجعله نموذجًا في التمكين والابتكار المؤسسي.
يمكن القول إنّ النظام السعودي يُجسّد “حوكمة الأداء”، في حين يُجسّد النظام الإماراتي “قيادة الأداء”. الأول يُؤسس للنظام، والثاني يُؤسس للثقافة. وحين تلتقي الحوكمة بالثقافة، تتكوّن بيئة الأداء المثالية التي تجمع بين الانضباط والإبداع، وبين الالتزام والتحفيز.
🧠 رابعًا: الملامح المشتركة في النضج المؤسسي الخليجي
على الرغم من اختلاف التفاصيل، إلا أنّ التجارب الخليجية في إدارة الأداء تتفق على خمس سماتٍ محوريةٍ تُعبّر عن النضج المؤسسي الحديث:
1️⃣ التشاركية في صياغة الأهداف بين الموظف والقائد.
2️⃣ التركيز على الجودة لا الكمية في تقييم الأداء.
3️⃣ الدمج بين الأهداف السلوكية والفنية في منظومةٍ واحدةٍ.
4️⃣ المراجعة الدورية للأداء لضمان التطوير المستمرّ.
5️⃣ الربط بين الأداء الفردي والمؤسسي في إطارٍ وطنيٍّ متكاملٍ.
هذه السمات تُعبّر عن تحوّلٍ نوعيٍّ من الثقافة الإدارية التقليدية إلى ثقافة الأداء الاستراتيجي التي ترى الإنسان ليس أداةً للإنتاج فقط، بل شريكًا في صناعة المستقبل المؤسسي.
🪞 خامسًا: الخلاصة التحليلية
إنّ قراءة الأهداف في الأنظمة الخليجية الرسمية تُظهر بوضوحٍ أن المنطقة قد دخلت مرحلةً جديدةً من التفكير في إدارة الأداء — مرحلة تتجاوز النماذج الغربية التقليدية نحو نموذجٍ عربيٍّ خليجيٍّ ناضجٍ ومتكاملٍ يقوم على التوازن بين التقنية والإنسان، وبين النظام والمرونة، وبين العدالة والتحفيز.
فالهدف في النظام السعودي يُعبّر عن الواجب المؤسسي، وفي النظام الإماراتي يُعبّر عن الشغف الوطني. وفي التقاء الواجب بالشغف، تُولد ثقافة الأداء الخليجي الجديدة — ثقافةٌ تُدير الإنسان لا كرقمٍ في نظام، بل كقيمةٍ مضافةٍ في رحلة التنمية الوطنية.
وهكذا تتحول الأهداف من أدواتٍ للمساءلة إلى جسورٍ للتمكين، ومن مؤشراتٍ للقياس إلى مناراتٍ للتطوير، لتُصبح إدارة الأداء ركيزةً من ركائز بناء الدولة الحديثة، التي تُؤمن بأنّ جودة الأداء ليست في كثرة التقارير، بل في وضوح الغايات، وعدالة القياس، وصدق الأثر في الإنسان والمجتمع.
🌍 من الهدف إلى المعيار: بناء بيئة قياسٍ واعيةٍ تدعم العدالة والتطوير المستمر
حين نتأمل تطوّر مفهوم الأداء في الفكر الإداري الحديث، ندرك أن المؤسسات لم تعد تُقاس بما تُنجزه من مهام، بل بما تخلقه من أثرٍ يمكن التحقق منه بموضوعيةٍ وعدالةٍ. غير أن الوصول إلى هذا الأثر لا يتحقق بمجرد كتابة الأهداف، بل يتطلّب بناء منظومةٍ قياسيةٍ ناضجةٍ تُحوّل الأهداف إلى معايير، والمعايير إلى مؤشرات، والمؤشرات إلى وعيٍ مؤسسيٍّ يُوجّه الفعل ويُراقب النتيجة. إنّ “القياس” في فلسفة الأداء الحديثة ليس عمليةً رقميةً باردة، بل هو أداةُ وعيٍ وإدارةٍ وتعلّمٍ. فالمؤسسة التي تُحسن القياس تُحسن الفهم، ومن ثم تُحسن القرار.
الانتقال من “الهدف” إلى “المعيار” يُعبّر عن التحوّل من التفكير الوصفي إلى التفكير التحليلي، أي من الاكتفاء بقول “نريد أن نُحسّن” إلى السؤال “كيف سنعرف أننا تحسّنا؟”. وهذه النقلة هي التي تميّز المؤسسات الناضجة عن المؤسسات الإجرائية، لأنّ الأولى تُحوّل الأداء إلى علمٍ يمكن اختباره، بينما الثانية تتركه في دائرة الانطباعات والتقديرات الشخصية.
🧩 أولًا: من الغاية إلى المعيار – التحول من النية إلى الدليل
كل هدفٍ مؤسسيٍّ يبدأ بنيّةٍ حسنةٍ لتحقيق إنجازٍ ما، لكنّ النوايا وحدها لا تُقاس. لذلك وُجد المعيار ليُحوّل النية إلى دليلٍ قابلٍ للقياس والتحقق. فالهدف يقول: “أُريد أن أرفع جودة التقارير”، أما المعيار فيسأل: “ما المقصود بالجودة هنا؟ وكيف سنعرف أنها تحققت؟”. ومن خلال الإجابة على هذا السؤال تتكوّن لغة العدالة المؤسسية.
فالمعيار هو الجسر بين التفكير والرصد، بين الفكرة والمشاهدة، بين الوصف والإثبات. إنّه ما يجعل الأداء علمًا يمكن متابعته وتحسينه. ولهذا، فإنّ المعيار ليس مجرد رقمٍ أو نسبةٍ، بل هو صياغةٌ لِما يُعتَبَر دليلًا على النجاح في تحقيق الهدف.
فعندما نقول مثلًا: “تحسين رضا المتعاملين بنسبة 10٪”، فإنّ الهدف هنا هو “تحسين الرضا”، بينما المعيار هو “زيادة النسبة المسجلة في استبيان رضا المتعاملين خلال فترةٍ محددةٍ”. هذا التحديد يجعل الأداء موضوعًا للفحص والتحليل، لا للتقدير الشخصي.
إنّ التحول من الغاية إلى المعيار هو ما يُحوّل الأداء من تجربةٍ ذاتيةٍ إلى عمليةٍ مؤسسيةٍ قابلةٍ للمساءلة، وهو ما يضمن أن تكون النتائج قابلةً للمقارنة عبر الزمن وبين الوحدات المختلفة داخل المؤسسة.
⚙️ ثانيًا: بناء بيئة القياس – من المؤشرات إلى الثقافة
لكي تنجح المؤسسة في تحويل الأهداف إلى معايير، فإنّها تحتاج إلى بيئةٍ قياسيةٍ واعيةٍ تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية: النظام، والثقافة، والمهارة.
1️⃣ النظام:
هو البنية الإجرائية والتقنية التي تُتيح جمع البيانات وتحليلها ومراجعتها بانتظام. ويشمل أدواتٍ مثل أنظمة إدارة الأداء الإلكترونية (HRMS)، ونماذج مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs)، ولوحات المتابعة الرقمية (Dashboards). وجود هذا النظام يُقلّل من التقديرات الشخصية ويُعزّز الموثوقية في الحكم على الأداء.
2️⃣ الثقافة:
القياس ليس إجراءً محايدًا، بل ثقافةٌ تحتاج إلى ترسيخٍ في وعي الموظفين. فالكثيرون ما زالوا ينظرون إلى القياس بوصفه أداةً للعقاب لا أداةً للتعلّم، فيتخوّفون من نتائجه بدلًا من الاستفادة منها. لذلك يجب أن تُعيد المؤسسة تعريف القياس في أذهان العاملين بأنه أداة تحسينٍ لا أداة محاسبةٍ، وبأنه مرآةٌ تُظهر الواقع لا عصًا تُلوّح بالتهديد.
3️⃣ المهارة:
مهارة القياس تتطلب تدريبًا متخصصًا في تصميم المؤشرات، وتحديد أدوات التحقق، وتحليل النتائج. فالكثير من المؤسسات تمتلك أهدافًا جيدةً لكنها تفشل في قياسها لأنّ العاملين لا يعرفون كيف يُحوّلونها إلى مؤشراتٍ واقعيةٍ. لذا، ينبغي أن تُدرّب القيادات والموظفين على مهارات القياس والتحليل والتفسير لضمان نزاهة النتائج ودقتها.
ومن خلال دمج هذه العناصر الثلاثة – النظام، والثقافة، والمهارة – تتكوّن بيئةٌ قياسيةٌ ناضجةٌ تُحوّل القياس من عمليةٍ موسميةٍ إلى ممارسةٍ يوميةٍ تعيش في تفاصيل الأداء المؤسسي.
💡 ثالثًا: من المؤشر إلى البصيرة – القياس كأداة وعيٍ لا محاسبة
يُخطئ من يظنّ أن القياس غايته جمع الأرقام فقط، لأنّ الرقم لا قيمة له دون معنى. فالقياس الحقيقي هو الذي يُولّد البصيرة، أي القدرة على فهم “لماذا” تحقق الهدف أو لم يتحقق. ومن هنا، فإنّ المعيار الجيد ليس الذي يُظهر النتيجة فقط، بل الذي يُساعد على تفسيرها.
فحين تُسجّل المؤسسة مثلًا “انخفاضًا في رضا العملاء بنسبة 5٪”، فإنّ هذا الرقم في ذاته لا يُقدّم حلاً ولا توجيهًا، ما لم يُحلّل في ضوء أسبابه: هل الخلل في جودة الخدمة؟ أم في التواصل؟ أم في توقيت الاستجابة؟ وعندما تُحوّل المؤسسة نتائج القياس إلى تحليلٍ تفسيريٍّ، فإنّها تنتقل من القياس الكمي إلى القياس الإدراكي (Perceptual Measurement) الذي يُعبّر عن وعيٍ ناضجٍ بالأداء.
ومن هذا المنطلق، فإنّ المؤسسات الخليجية الرائدة بدأت تُعيد تصميم أنظمة القياس لديها لتُركّز على المعنى لا الرقم فقط. ففي النظام الإماراتي (EPMS) مثلًا، يتم تحليل نتائج الأهداف ضمن اجتماعات التغذية الراجعة النصف سنوية، حيث تُناقَش الأرقام في سياقها، ويُستخرج منها الدروس والتحسينات المستقبلية. أما في النظام السعودي، فإنّ الدليل الإرشادي يؤكد على “تفسير نتائج التقييم وربطها بخطط التطوير الفردي”، وهو ما يعني أن القياس لم يعد غايةً، بل وسيلةً للتعلّم والتحسين المستمرّ.
🧮 رابعًا: العدالة في القياس – من المعيار إلى المساواة في الفرص
العدالة هي روح القياس. فلا قيمة لأي نظامٍ إداريٍّ إذا لم يُشعر العاملين بأنّهم يُقيَّمون بمعايير واحدةٍ واضحةٍ ومعلنةٍ. غير أن العدالة في القياس لا تتحقق بالمساواة الشكلية فقط، بل بالمواءمة بين المعيار وسياق الوظيفة. فالوظائف تختلف في طبيعتها، والأهداف تتفاوت في صعوبتها، والفرص المتاحة لإنجازها ليست متكافئةً دائمًا. لذلك يجب أن يُراعى في تصميم المعايير أن تكون “منصفةً” لا “متطابقةً”.
فعلى سبيل المثال، لا يجوز تقييم موظفٍ ميدانيٍّ ومُوظفٍ مكتبيٍّ بالمؤشر نفسه، لأنّ طبيعة التحديات تختلف. ولا يصحّ مقارنة أداء إدارةٍ تمتلك موارد عاليةٍ بإدارةٍ تعمل في ظروفٍ محدودةٍ. العدالة في القياس هنا تعني المرونة المنضبطة، أي أن يُستخدم المعيار نفسه من حيث المفهوم، لكن يُطبّق بطريقةٍ تراعي السياق دون أن تُخلّ بالإنصاف.
ولهذا، تُشدّد الأنظمة الخليجية الحديثة على مبدأ “العدالة السياقية” في تقييم الأداء، إذ يُؤكّد النظام السعودي على أنّ “المدير مسؤولٌ عن ضمان واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق ضمن الإمكانات المتاحة”، بينما ينصّ النظام الإماراتي على أن “يُراعى عند تقييم الأداء التوازن بين الموارد المتاحة والنتائج المحققة”.
هذه العدالة ليست مجرد قيمةٍ أخلاقيةٍ، بل شرطٌ إداريٌّ أساسيٌّ للحفاظ على الثقة المؤسسية. فالموظفون لا يعترضون على التقييم المنصف حتى لو كانت نتيجتهم متدنية، لكنهم يرفضون التقييم الغامض أو غير العادل، لأنّ الغموض يُدمّر الثقة، والثقة هي العمود الفقري لكل منظومة أداءٍ ناجحةٍ.
🧭 خامسًا: من القياس إلى التحسين – دورة PDCA في بيئة الأداء
لكي تُثمر المعايير في تطوير الأداء، يجب أن تتحوّل نتائج القياس إلى مدخلاتٍ لعمليات التحسين المستمرّ. وهنا يأتي دور دورة الجودة الشهيرة (PDCA) التي صاغها إدوارد ديمنغ، وتقوم على أربع مراحلٍ متتابعةٍ:
1️⃣ Plan – التخطيط: وضع الأهداف والمعايير بوضوحٍ.
2️⃣ Do – التنفيذ: تطبيق الخطط ومتابعة الأداء.
3️⃣ Check – الفحص: تحليل النتائج ومقارنتها بالمعايير.
4️⃣ Act – التصحيح: اتخاذ إجراءات التحسين بناءً على الفجوات المكتشفة.
إنّ هذا النموذج يُحوّل القياس من مرحلةٍ نهائيةٍ إلى حلقةٍ مستمرةٍ من التعلم والتطوير. فكل مرةٍ تُقاس فيها النتائج تُصبح فرصةً لتصحيح المسار وتحسين الممارسات. وهكذا، لا يُنظر إلى القياس على أنه “حكمٌ” بل على أنه “تغذيةٌ راجعةٌ” تُغذّي النظام بالخبرة والمعرفة.
وتُعتبر المؤسسات التي تُطبّق هذا المبدأ مؤسساتٍ ناضجةً، لأنها لا تُخفي نتائجها ولا تتعامل معها بعقلية العقاب، بل بعقلية التعلّم. ففي بيئة الأداء الواعية، لا يُخاف من الرقم، بل يُستفاد منه. فالفشل في تحقيق الهدف ليس نهايةً، بل بدايةُ فهمٍ جديدٍ يُعيد صياغة النجاح.
💬 سادسًا: الأثر النفسي والثقافي لبيئة القياس
لا يمكن بناء نظام قياسٍ ناجحٍ دون الاهتمام بالبعد الإنساني. فالأرقام وحدها لا تُلهم، بل قد تُرهق الموظفين إذا لم تُقدّم في سياقٍ إيجابيٍّ تحفيزيٍّ. فبيئة القياس الواعية هي تلك التي تُدير مشاعر الموظفين تجاه التقييم كما تُدير نتائجه.
حين يشعر الموظف أن نتائج القياس ستُستخدم لتحسينه لا لمعاقبته، فإنه يُصبح أكثر صدقًا في تقديم البيانات وأكثر حماسًا لتحقيق الأهداف. أما إذا شعر أن القياس يُستخدم كأداةٍ للتهديد، فإنه سيُخفي الأخطاء أو يُزيّف الأرقام ليحمي نفسه، فتضيع الحقيقة ويتحوّل النظام إلى بيروقراطيةٍ قاتلةٍ للثقة.
من هنا، فإنّ بناء ثقافةٍ إيجابيةٍ حول القياس هو أحد أعمدة إدارة الأداء الحديثة. ويبدأ هذا التحول من القيادة، لأنّ القائد هو من يُعيد تعريف معنى القياس في أذهان الموظفين. فالقائد الواعي يقول: “نقيس لنتعلم”، لا “نقيس لنعاقب”.
🌱 سابعًا: من القياس إلى الحوكمة
عندما تتطور بيئة القياس وتترسخ معاييرها وتنتظم بياناتها، تنتقل المؤسسة إلى مستوى أعلى يُعرف بـ حوكمة الأداء (Performance Governance). في هذه المرحلة، لا يكون القياس مجرد عمليةٍ داخليةٍ، بل نظامًا متكاملًا للشفافية والمساءلة والمقارنة المؤسسية.
القياس هنا يُصبح لغةَ الحوكمة التي تربط الأهداف بالقرارات، وتربط الموارد بالنتائج. فالمؤشرات لا تُستخدم فقط لتقييم الموظفين، بل لتوجيه السياسات، وتحديد الأولويات، ورصد مستوى التقدم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
ومن أبرز النماذج التي تطبّق هذا المفهوم في العالم نظام بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard)، الذي يُحوّل الرؤية المؤسسية إلى مجموعةٍ من مؤشرات الأداء في أربعة أبعادٍ: المالي، والعملاء، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو. هذا النموذج يجعل من القياس وسيلةً لربط الأداء الفردي بالنجاح المؤسسي الشامل.
وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية الخليجية بتبني هذا النموذج ضمن خططها الاستراتيجية، مما يُظهر تطور الفكر الإداري من مستوى التنفيذ إلى مستوى الحوكمة الاستراتيجية للأداء.
🪞 خلاصة المحور
إنّ الانتقال من الهدف إلى المعيار ليس مجرّد تطورٍ في أدوات الإدارة، بل هو تحوّلٌ في الوعي المؤسسي. فحين تُصبح المؤسسة قادرةً على قياس أدائها بموضوعيةٍ وعدالةٍ وشفافيةٍ، فإنها تُصبح قادرةً على تطوير نفسها باستمرارٍ دون الحاجة إلى ضغوطٍ خارجيةٍ.
القياس هو مرآةُ الحقيقة، والمعيار هو لسان العدالة، والوعي هو الذي يمنح الاثنين معناهما. والمؤسسة التي تُدير هذه المعادلة بذكاءٍ تُحوّل نظام الأداء من أداةٍ للتقييم إلى أداةٍ للتنوير والتطوير والتحسين المستدام، لأنّها حين تقيس بعين العدالة، ترى بعين البصيرة، وتبني بعين المستقبل.
🪞 الخاتمة التحليلية: تكامل الهدف، والقياس، والأثر في منظومة الأداء الوظيفي
حين نصل إلى نهاية هذه الرحلة الفكرية الممتدة عبر محاور المقال، ندرك أننا لم نكن نتحدث عن "كتابة أهدافٍ" بقدر ما كنا نتأمل كيف تفكر المؤسسة في ذاتها، وكيف ترى الإنسان داخلها. فالأهداف ليست نصوصًا مكتوبةً على الورق، بل هي بوصلةُ وعيٍ تُوجّه السلوك، وتبني العدالة، وتُحوّل الجهد الفردي إلى طاقةٍ مؤسسيةٍ تُسهم في صنع المستقبل. إنّ الحديث عن "الهدف" هو في جوهره حديثٌ عن "المعنى"، لأنّ الهدف هو الذي يُحوّل العمل إلى قصد، والنية إلى نتيجة، والفعل إلى أثرٍ يُقاس ويُبنى عليه.
لقد رأينا في المحاور السابقة كيف يتدرّج مفهوم الهدف من مهمةٍ بسيطةٍ إلى غايةٍ مؤسسيةٍ، وكيف يتحول من نشاطٍ إلى نتيجةٍ، ومن نتيجةٍ إلى معيارٍ، ومن معيارٍ إلى وعيٍ مؤسسيٍّ يُنتج التحسين المستمرّ. ومع كل هذا التدرج، يبقى العنصر الإنساني هو المركز الحقيقي للمنظومة، لأنه هو من يضع الهدف، ويقيسه، ويفهمه، ويحوّله إلى واقعٍ حيٍّ في بيئة العمل.
إنّ التكامل بين الهدف والقياس والأثر لا يحدث تلقائيًا، بل هو ثمرةُ نظامٍ واعٍ وثقافةٍ ناضجةٍ تُدرك أن الأداء ليس غايةً في ذاته، بل وسيلةٌ لتطوير الإنسان والمؤسسة والمجتمع معًا. فحين تُصاغ الأهداف بذكاء، وتُقاس بمعايير منصفة، وتُحلَّل بنتائج شفافة، يتحوّل نظام الأداء من إجراءٍ بيروقراطيٍّ إلى رحلةِ نضجٍ مؤسسيٍّ متواصلةٍ.
🌿 أولًا: الهدف — من النص إلى الغاية
الهدف هو نقطة البدء، لكنه أيضًا انعكاسٌ لفلسفة المؤسسة في النظر إلى العمل. فالمؤسسات التي ترى الهدف بوصفه "مهمةً يجب إتمامها" تُنتج بيئةً تشغيليةً محدودة الأفق، أما المؤسسات التي ترى الهدف بوصفه "رسالةً يجب تحقيق أثرها" فهي التي تُنتج بيئةً قياديةً ومبدعةً.
ولذلك فإنّ كتابة الأهداف ليست عمليةً لغويةً، بل فكريةٌ بالدرجة الأولى. إنها اختبارٌ لمدى وضوح الرؤية، ونضج التفكير، ودقة الفهم للارتباط بين العمل والنتيجة. فكل هدفٍ مكتوبٍ هو انعكاسٌ لوعي صاحبه؛ وكلما كان الهدف أوضح وأقرب للقياس، دلّ على نضجٍ إداريٍّ أكبر.
وحين يُصبح الهدف جزءًا من ثقافة العمل اليومية، تتحول المؤسسة إلى كيانٍ يفكر بالغايات لا بالأعمال فقط، ويُدير الوقت بوصفه استثمارًا لا عبئًا، ويُقيّم النجاح بالأثر لا بالكمّ.
⚙️ ثانيًا: القياس — من الأرقام إلى البصيرة
القياس هو الجسر الذي يربط الهدف بالواقع، وهو الذي يمنح المؤسسة عينًا ترى بها نتائجها بوضوح. لكنّ القياس في المفهوم الحديث لا يعني العدّ والإحصاء فحسب، بل يعني الفهم والتحليل والتفسير. إنّ الرقم بلا بصيرةٍ يصبح شكلًا بلا مضمون، والبيانات بلا وعيٍ تُنتج قراراتٍ عمياء.
ولذلك فإنّ المؤسسات الناضجة تُدرك أنّ القياس ليس أداة محاسبةٍ فقط، بل أداة تعلمٍ وتطوير. فهي لا تخشى الأرقام التي تُظهر الفجوات، لأنها تراها فرصةً للتحسين، لا دليلاً على الفشل. والقيادة الحكيمة هي التي تُحوّل التقارير الرقمية إلى حواراتٍ معرفيةٍ تُولّد الأفكار، وتُعيد ضبط الاتجاه، وتُحفّز على التغيير الإيجابي.
إنّ القياس العادل هو الذي يُوازن بين الكمّ والنوع، بين الأداء والإمكانات، بين النتائج والسياق. فحين تُقاس الجهود بمعايير منصفةٍ تراعي الظروف الواقعية، يُولد شعورٌ بالعدالة يُحفّز الانتماء والإبداع، ويُحوّل نظام الأداء إلى نظامٍ يثق به الجميع.
🧭 ثالثًا: الأثر — من النتائج إلى القيمة
لا قيمة لهدفٍ يُكتب أو يُقاس ما لم يُحدث أثرًا حقيقيًا. فالأثر هو الغاية النهائية لكل جهدٍ إداريٍّ أو مؤسسيٍّ، وهو المعيار الأعلى لنجاح نظام الأداء. والأثر هنا لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بما يتركه الأداء من تحوّلٍ إيجابيٍّ في السلوك، والكفاءة، والثقافة، والنتائج المجتمعية.
فالمؤسسة التي تُحسّن جودة خدماتها لا تُغيّر أرقامًا في التقارير فقط، بل تُغيّر تجربة الناس وثقتهم بها. والمؤسسة التي تُنمّي قدرات موظفيها لا تُنفق على التدريب فقط، بل تستثمر في طاقاتٍ تُعيد تشكيل مستقبلها. وهكذا يصبح الأداء لغةً أخلاقيةً وثقافيةً بقدر ما هو لغةٌ إداريةٌ وقياسيةٌ.
إنّ الأثر الحقيقي لنظام الأداء الوظيفي يظهر حين يتحوّل الإنسان من موظفٍ يؤدّي ما يُطلب منه إلى شريكٍ يبتكر ما تحتاجه المؤسسة. وهذا لا يتحقق إلا عندما تُدار الأهداف والقياسات ضمن فلسفةٍ تُركّز على بناء الإنسان لا مجرد محاسبته، وعلى تحفيز الوعي لا مجرد رصد الإنتاجية.
🧩 رابعًا: العلاقة التكاملية بين الأهداف والمؤشرات والأثر
في المؤسسة الناضجة، لا تُكتب الأهداف بمعزلٍ عن المؤشرات، ولا تُقاس المؤشرات بمعزلٍ عن الأثر. فهذه العناصر الثلاثة تُشكّل مثلث الأداء الذي يُعبّر عن النضج الإداري:
-
الهدف يجيب عن سؤال: ما الذي نريد تحقيقه؟
-
القياس يجيب عن سؤال: كيف سنعرف أننا حققناه؟
-
الأثر يجيب عن سؤال: ما القيمة التي أضفناها بتحقيقه؟
وحين تتكامل هذه الأبعاد الثلاثة، يُصبح الأداء منظومةً متكاملةً تربط الفكر بالفعل، والرؤية بالإنجاز، والتخطيط بالتحسين. فالمؤسسة التي تُدير أهدافها بمعاييرٍ واضحةٍ وتُحلّل نتائجها بأدواتٍ علميةٍ، تُصبح قادرةً على تحويل التجربة اليومية إلى معرفةٍ تراكميةٍ تُغذي الوعي المؤسسي.
💡 خامسًا: فلسفة التحول من التقييم إلى التمكين
أحد أهم الدروس التي تُعلّمنا إياها أنظمة الأداء الخليجية الحديثة هو أن إدارة الأداء ليست نظامًا للرقابة بل منصةٌ للتمكين. فالغاية ليست أن نحكم على الموظف بدرجةٍ، بل أن نُساعده على النمو والتطور وتحقيق ذاته ضمن رؤية المؤسسة.
فالمؤسسة الواعية هي التي تزرع في موظفيها شعورًا بأنّ الأهداف وُضعت لتدعمهم لا لتُرهقهم، وأنّ التقييم يُراد به تطويرهم لا تصنيفهم، وأنّ الحوار حول الأداء هو حقّهم قبل أن يكون واجبًا عليهم. في هذه البيئة، يتحوّل القائد من مُقيّمٍ إلى مُرشدٍ، ويتحوّل الموظف من مُتلقٍّ إلى شريكٍ في صناعة الأثر.
وهذه هي الفلسفة التي تُحوّل نظام الأداء من عمليةٍ إداريةٍ جامدةٍ إلى رحلةٍ إنسانيةٍ للتعلّم والتحسين والتمكين. فالموظف الذي يُدير أداءه بوعيٍ هو الذي يُدير مستقبله المهني، والمؤسسة التي تُدير أداءها بإنصافٍ هي التي تضمن استدامتها وريادتها في عالمٍ سريع التغير.
🌍 سادسًا: نحو بيئة أداءٍ عربيةٍ ناضجة
إنّ التجارب الخليجية والعربية في إدارة الأداء تمثل اليوم مدرسةً متقدمةً تتجاوز الاقتباس من النماذج الغربية نحو إبداع نموذجٍ عربيٍّ متكاملٍ يجمع بين العقل المؤسسي الحديث والقيم الإنسانية الراسخة. هذا النموذج يوازن بين القياس والرحمة، وبين العدالة والتحفيز، وبين النظام والمرونة.
في هذا النموذج، يُصبح الهدف وسيلةً للوعي الجمعي، والقياس أداةً للشفافية، والأثر معيارًا للتنمية المستدامة. والمؤسسة العربية حين تتقن هذا التوازن، فإنها لا تُحاكي تجارب الآخرين، بل تُنتج تجربتها الخاصة التي تُعبّر عن روحها الثقافية وهويتها القيمية.
فالقيم الإسلامية والعربية التي تُعظّم الإتقان، وتُكرّم العمل، وتدعو إلى العدل، هي في جوهرها المبادئ التي تقوم عليها إدارة الأداء الحديثة. وحين تُدمج هذه القيم في الأنظمة والإجراءات، يتكوّن نظام أداءٍ أخلاقيٍّ وإنسانيٍّ يربط الكفاءة بالمروءة، والنجاح بالمسؤولية، والمكافأة بالاستحقاق الحقيقي.
🧠 سابعًا: البعد المستقبلي — من الأداء إلى الاستدامة
المؤسسات الرائدة لا تكتفي بقياس الأداء، بل تُحوّله إلى نظامٍ للتعلّم التنظيمي والاستدامة. فهي ترى في كل هدفٍ فرصةً لاختبار المنهج، وفي كل قياسٍ فرصةً لتعلّمٍ جديدٍ، وفي كل نتيجةٍ فرصةً لتصحيح المسار.
ومع تطور أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في نظم الموارد البشرية (HR Analytics)، أصبح بالإمكان ربط الأهداف الفردية بالتحسين المؤسسي عبر تحليل البيانات التنبؤية (Predictive Analytics)، مما يُمكّن القادة من استشراف التحديات المستقبلية واتخاذ قراراتٍ مبنيةٍ على الأدلة.
إنّ المستقبل الإداري يتّجه نحو أنظمةٍ “تتعلّم من نفسها”، أي أن نظام الأداء لن يكون مجرد أداةٍ للرصد، بل نظامًا ذكيًا للتحسين الذاتي المستمرّ، يُحلّل البيانات، ويقترح التطوير، ويُوجّه القرارات بناءً على أنماط الأداء التاريخي. وهذا هو أفق التحول الذي بدأت بعض المؤسسات الخليجية تسير نحوه بالفعل ضمن خطط التحول الرقمي والحوكمة الذكية للأداء.
🪞 ثامنًا: الختام — الإنسان هو الهدف والغاية
في نهاية المطاف، وبعد كل الأطر والنماذج والمعايير، يبقى الإنسان هو محور الأداء وغايتُه. فالنظام الذي ينجح في رفع الكفاءة لكنه يُهدر كرامة الإنسان قد حقق الأرقام وخسر المعنى، بينما النظام الذي يُنمّي الإنسان يُنمّي معه المؤسسة والمجتمع والوطن.
إدارة الأداء في جوهرها ليست فنّ القياس فحسب، بل فنّ الإنصاف وفلسفة الإتقان. إنها تعبيرٌ عن إيمان المؤسسة بأنّ النجاح الحقيقي لا يُقاس بالنتائج وحدها، بل بعمق القيم التي تُوجّه تلك النتائج.
وحين تُصبح المؤسسة قادرةً على صياغة أهدافٍ واعيةٍ، وقياسٍ عادلٍ، وأثرٍ مستدامٍ، فإنها تُعلن بلوغها مرحلة النضج المؤسسي الكامل — حيث يتحول الأداء إلى وعيٍ، والوعي إلى ثقافةٍ، والثقافة إلى استدامةٍ تُخلّد أثر الإنسان في عمله.
✍🏻 التوثيق للمقال
📢 يسعدني أن يُعاد نشر هذا المحتوى أو الاستفادة منه في التدريب والتعليم والاستشارات،
ما دام يُنسب إلى مصدره ويحافظ على منهجيته.
✍🏻 هذه الإضاءة من إعداد:
د. محمد بن علي العامري
مدرب وخبير استشاري في التنمية الإدارية والتعليمية،
بخبرةٍ تمتدّ لأكثر من ثلاثين عامًا في التدريب والاستشارات والتطوير المؤسسي.
📲 للمزيد من الإضاءات والمعارف النوعية،
ندعوكم للاشتراك في قناة د. محمد العامري على الواتساب عبر الرابط التالي:
🔗 https://whatsapp.com/channel/0029Vb6rJjzCnA7vxgoPym1z
🌐 تصفّح المزيد من المقالات عبر الموقع:
👉 www.mohammedaameri.com
🔖 #إدارة_الأداء_الوظيفي #Performance_Management #قياس_الأداء #SMART_Goals #الأهداف_الذكية #تقييم_الأداء #مهارات_القيادة #د_محمد_العامري #مهارات_النجاح #التطوير_المؤسسي #حوكمة_الأداء #التحفيز_المهني #الجدارات_السلوكية #إدارة_الموارد_البشرية #HR_Development #HR_Strategy #EFQM #ISO30414 #CIPD #SHRM #التخطيط_الاستراتيجي #إدارة_الكفاءات #التميز_المؤسسي #Continuous_Improvement #Organizational_Performance #مهارات_الإشراف #Culture_of_Performance #التحول_المعرفي #القيادة_بالقيم #التمكين_الوظيفي #الأداء_القابل_للقياس